
Pourquoi sont-ils devenus musulmans ?
Nous sommes ici pour ouvrir une fenêtre honnête, calme et respectueuse sur l'islam.
Sur cette page, nous mettons en lumière les histoires de personnes d'origines, de cultures et de religions différentes qui ont choisi l'islam avec conviction après un parcours de recherche et de réflexion.
Il ne s'agit pas seulement d'anecdotes personnelles, mais de témoignages honnêtes qui expriment le changement profond que l'islam a apporté dans leur cœur et leur esprit, les questions auxquelles ils ont trouvé des réponses et la tranquillité qu'ils ont ressentie après l'islam.
Que l'histoire ait commencé par une recherche philosophique, par la curiosité ou même par une situation humaine touchante, le dénominateur commun de ces expériences est la lumière qu'ils ont trouvée dans l'islam et la certitude qui a remplacé le doute.
Nous présentons ces histoires en plusieurs langues, sous forme écrite et visuelle, afin d'inspirer et d'introduire l'islam par le biais d'une expérience humaine vivante.

Grands noms devenus musulmans
Salman Al-Farisi - Le chercheur de vérité

Il s'agissait d'une histoire de Le grand compagnon Salman al-Farsi Salman (qu'Allah soit satisfait de lui) a vécu avec le magiisme, le christianisme et le judaïsme avant l'avènement de l'islam, et a continué à chercher la vraie religion jusqu'à ce qu'Allah le guide vers elle. Il n'a pas abandonné son esprit et son cœur aux traditions et aux croyances héritées de son pays, car s'il s'y était accroché jusqu'à sa mort, il n'aurait pas été l'un des compagnons du Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui). Il n'aurait pas été converti à la religion de l'islam et serait mort dans son polythéisme.
Bien qu'il ait grandi en Perse au milieu du culte du feu, Salman le Persan était à la recherche de la vraie religion et est parti à la recherche de Dieu. Il n'était pas convaincu de cette religion, mais comme ses parents y étaient attachés, il l'a embrassée avec eux. Lorsque ses doutes sur sa religion et celle de sa famille se sont intensifiés, Salman a quitté son pays, la Perse, et a émigré au Levant à la recherche de la vérité religieuse absolue. Il a rencontré des moines et des prêtres au Levant et, après un long voyage, Salman est arrivé comme esclave à Médine. Lorsqu'il a entendu parler du Prophète (sur lui la paix), il l'a rencontré et s'est converti à l'islam après avoir été convaincu de son message.
Salman a grandi dans la descendance d'une famille aristocratique, vivant au paradis en Perse, et son père l'aimait tellement et le craignait tellement qu'il l'enfermait dans sa maison, et Salman avait progressé dans le magiisme jusqu'à devenir l'habitant du feu qui brûle et ne le laisse pas s'éteindre pendant une heure.
Un jour, son père lui demande de se rendre à son domaine pour s'en occuper en raison de son emploi du temps chargé et lui demande de ne pas être en retard pour qu'il ne s'inquiète pas. Sur le chemin du domaine, Salman passe devant une église où les gens prient, il entre et les admire et dit : "Ceci - par Dieu - est mieux que la religion que nous pratiquons". Il ne les quitte pas jusqu'au coucher du soleil.
Salman est retourné voir son père et lui a raconté ce qui s'était passé. Il lui a dit qu'il était impressionné par cette religion et l'a enchaîné.
Salman raconte : J'ai envoyé des chrétiens et je leur ai dit : "Si un groupe de marchands du Levant vient à vous, parlez-moi d'eux". Ils le lui ont dit et il s'est enfui de la maison de son père vers le Levant.
Lorsque celui-ci mourut, on lui recommanda d'aller voir un évêque de Mossoul qui était dans le même état de droiture et attendait la mission du Prophète ; il alla donc le voir et resta avec lui pendant un certain temps. Lorsque celui-ci mourut, on lui recommanda d'aller voir un évêque de Nusaybin, et l'affaire se répéta jusqu'à ce qu'il arrive à un évêque du peuple d'Amauria à Rome, qui lui parla de l'époque du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix et les bénédictions. L'évêque lui dit : "Mon fils, par Dieu, je ne sais pas s'il reste quelqu'un qui soit dans la même situation que nous, alors je t'ordonne de venir à lui, mais le temps est venu pour un prophète d'être envoyé du sanctuaire, dont l'émigration se fera entre deux libertés vers une terre déserte avec des palmiers, et il y aura en lui des signes qui ne seront pas cachés, et entre ses épaules se trouve le sceau de la prophétie, et il mangera un cadeau et ne mangera pas la charité, alors si tu peux te rendre dans ce pays, fais-le.
Il partit avec eux à la recherche du prophète de la fin des temps, mais en chemin, ils le vendirent à un juif et l'amenèrent à Médine, où il reconnut à ses palmiers qu'il s'agissait de la ville du Prophète (sur lui la paix) telle que l'évêque la lui avait décrite.
Salman raconte l'histoire de l'arrivée du Prophète à Médine : "Allah a envoyé son Prophète (paix et salut sur lui) à la Mecque sans me parler d'aucune de ses affaires, malgré mon esclavage, jusqu'à ce que le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) arrive à Qibaa, alors que je travaillais pour mon ami dans un palmier, quand j'ai entendu la nouvelle de l'arrivée du Prophète, je suis descendu en disant : "Quelle est cette nouvelle ?" Mon maître leva la main et me donna un violent coup de poing en disant : "Qu'est-ce que tu as, retourne à ton travail ?"
Salman voulait tester les qualités du prophète (sur lui la paix) dont l'évêque lui avait parlé, à savoir qu'il ne mange pas la charité et accepte les cadeaux, que l'anneau de la prophétie se trouve entre ses épaules et d'autres signes. Il est donc allé voir le prophète (sur lui la paix) le soir et a pris de la nourriture avec lui en lui disant que cette nourriture était de la charité, mais le prophète a ordonné à ses compagnons de manger et il n'a pas mangé, Salman a donc su qu'il s'agissait d'un des signes.
Puis il retourna voir le prophète (sur lui la paix), rassembla de la nourriture et lui dit que c'était un cadeau, et le prophète (sur lui la paix) et ses compagnons mangèrent, de sorte qu'il sut qu'il s'agissait du deuxième signe.
Salman a cherché l'anneau de la prophétie et a dit : "J'ai rencontré le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, alors qu'il suivait un enterrement et qu'il était dans ses compagnons, je me suis tourné vers son dos pour voir si je pouvais voir l'anneau qui m'avait été décrit. Lorsqu'il me vit me retourner, il comprit que je m'enquérais de quelque chose qui m'avait été décrit ; il jeta donc sa robe sur son dos, et je regardai l'anneau et le reconnus ; je m'agenouillai donc pour l'embrasser et je pleurai". Le Prophète (sur lui la paix) demanda aux compagnons du Prophète (sur lui la paix) de l'aider, et effectivement Salman fut libéré et resta un compagnon du Prophète (sur lui la paix), à tel point que le Prophète (sur lui la paix) dit : "Salman est l'un des nôtres de la famille de la maison".
Le voyage de Salman vers la vérité a été long et difficile : il est passé du magiisme en Perse au christianisme au Levant, puis à l'esclavage dans la péninsule arabique, jusqu'à ce que Dieu tout-puissant le guide vers le Prophète (Que la Paix soit sur lui) et l'islam.
Omar ibn al-Khattab (du plus hostile aux musulmans au calife des musulmans)
 'Omar ibn al-Khattab, compagnon du Messager d'Allah, était un homme fort et majestueux qui entra dans l'Islam à l'âge de vingt-six ans, et son ordre d'entrée dans l'Islam était après trente-neuf hommes, c'est-à-dire qu'il était le quarantième homme dans l'ordre de ceux qui sont entrés dans l'Islam, et cinquante ou cinquante-six ont été dits.
'Omar ibn al-Khattab, compagnon du Messager d'Allah, était un homme fort et majestueux qui entra dans l'Islam à l'âge de vingt-six ans, et son ordre d'entrée dans l'Islam était après trente-neuf hommes, c'est-à-dire qu'il était le quarantième homme dans l'ordre de ceux qui sont entrés dans l'Islam, et cinquante ou cinquante-six ont été dits.
Umar ibn al-Khattab (qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix) était l'un des plus féroces ennemis des musulmans avant de se convertir à l'islam.
Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) pria : "Ô Allah, renforce l'islam par les deux hommes qui te sont les plus chers, Abu Jahl ou Umar bin al-Khattab". Il répondit : "Umar était le plus cher des deux". C'était en effet l'entrée d'Umar dans l'islam.
L'histoire de l'islam d'Omar ibn al-Khattab
Voici l'histoire d'Omar ibn al-Khattab (qu'Allah soit satisfait de lui) : Umar ibn al-Khattab décida de tuer le Prophète Muhammad, car les Quraysh voulaient tuer le Prophète Muhammad, et ils se consultèrent sur la question de le tuer et sur l'homme qui le tuerait. Umar lui-même fut délégué, il prit donc son épée par une journée très chaude et se rendit auprès du Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, alors que le Prophète était assis avec ses compagnons, dont Abu Bakr al-Siddiq, Ali, Hamza, et quelques compagnons qui étaient restés avec le Messager d'Allah et n'étaient pas allés en Abyssinie. 'Omar ibn al-Khattab savait qu'ils étaient rassemblés à Dar al-Arqam au bas de Safa, et sur son chemin il fut rencontré par le compagnon Nu'ayem ibn Abdullah al-Naham, qui était musulman à l'époque, qui l'intercepta et lui demanda : "Il lui dit qu'il voulait tuer le Messager d'Allah parce qu'il avait insulté leurs dieux et leur religion. Les deux hommes lui crièrent dessus et il dit : " Quelle misérable promenade tu as faite, Umar " Il lui rappela la force des Banu Abdul Manaf et qu'ils ne le laisseraient pas partir, alors Umar lui demanda s'il était devenu musulman pour commencer à le tuer. Lorsque Naim vit qu'il ne renonçait pas à son objectif de tuer le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui), il l'en dissuada en lui disant que sa famille, sa sœur, le mari de celle-ci et son cousin étaient devenus musulmans.
L'attitude d'Omar ibn al-Khattab à l'égard de l'islam de sa sœur
'Umar ibn al-Khattab se rendit chez sa sœur pour se plaindre après que Nu'ayem lui ait parlé de l'islam de sa sœur. Sa sœur Fatima s'était convertie à l'islam avec son mari Sa'id, et le compagnon Khabbab ibn al-'Art leur enseignait le Coran. Lorsque 'Umar arriva, Khabbab lisait le Coran à Fatima et à son mari Sa'id, et il s'agissait de la sourate Taha. 'Umar les interrogea sur le bruit qu'il avait entendu, et ils lui dirent que c'était juste une conversation entre eux. 'Umar dit : " Peut-être es-tu devenu impatient " Sa'id lui dit : " Penses-tu, 'Umar, que la vérité est entre tes mains ? " 'Umar se leva pour le frapper, mais Fatima l'en empêcha, alors il la frappa sur son visage, et elle répondit avec colère en disant : 'Umar se leva pour le frapper, mais Fatima l'en empêcha et il la frappa sur le visage, et elle répondit avec colère en disant : " Lorsque 'Umar renonça à les frapper, il demanda le livre dans lequel ils lisaient, mais sa sœur ne lui donna pas le livre à moins qu'il ne se purifie, alors il s'exécuta et se purifia, puis il prit le livre et lut la sourate " Taha " jusqu'à ce qu'il atteigne " Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre dieu que moi, alors adorez-moi et priez pour mon souvenir " [Taha : 14] ". 'Umar s'émerveilla de la bonté des mots qu'il lisait, puis Khabib sortit et lui dit que le Messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'avait appelé à l'islam.
Déclaration d'Islam par Umar ibn al-Khattab entre les mains du Prophète
Quand Umar a lu les versets, il a demandé à Khabbab où se trouvait le Messager d'Allah pour qu'il puisse aller le voir et déclarer son Islam, et Khabbab lui a dit qu'il était dans la maison d'Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Ils eurent peur en entendant la voix d'Umar, mais Hamza les rassura et leur dit : " Si Allah le veut bien, il deviendra musulman, et s'Il veut le contraire, il nous sera facile de le tuer. " Ils l'amenèrent au Messager d'Allah. Hamza et un autre homme avaient saisi les bras d'Umar et l'avaient conduit au Messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Umar dit au Messager d'Allah qu'il voulait se convertir à l'Islam, alors le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix et les bénédictions, fit une grande proclamation, et ceux qui étaient dans la maison apprirent son Islam, et ils se réjouirent d'être devenus plus forts et plus puissants avec l'Islam de Hamza et d'Umar.
L'impact de l'Islam d'Umar sur la Dawa islamique
La conversion d'Omar ibn al-Khattab à l'islam a eu de nombreux effets ; à cette époque, les musulmans se sentaient fiers, forts et invincibles, car aucun d'entre eux ne pouvait prier en public ou faire le tour de la Kaaba, mais lorsque Omar est devenu musulman, les compagnons ont prié et fait le tour de la Kaaba, et ont obtenu justice de ceux qui leur avaient fait du tort. Umar annonça son islam aux polythéistes, qui furent déprimés par cette difficile nouvelle, et il informa Abu Jahl de son islam sans crainte ni inquiétude. Ibn Mas'ud se référa à cette signification et dit : "Nous ne pouvions pas prier à la Kaaba tant qu'Umar n'était pas devenu musulman". Ainsi, l'appel à l'islam devint public.
Dr Ingrid Mattsson
 Présentation
Présentation
Ingrid Mattson est professeur de religion au Hartford College dans le Connecticut. Elle est née et a grandi dans l'Ontario, au Canada, et a étudié la philosophie et l'esthétique à l'université de Waterloo.
Mme Mattson s'est convertie à l'islam au cours de sa dernière année d'université, s'est rendue au Pakistan en 1987, y a travaillé avec des réfugiés pendant un an et a obtenu son doctorat en études islamiques à l'université de Chicago en 1999.
Son histoire avec l'islam
Le Dr Ingrid a été élevée dans la foi chrétienne et n'était pas religieuse, et c'est par son amour de l'art qu'elle a découvert l'islam. Le Dr Ingrid raconte ses voyages dans les grands musées de Toronto, Montréal et Chicago, jusqu'à ce qu'elle visite le Louvre à Paris et soit profondément impressionnée par l'art de la peinture à travers les différentes étapes de l'histoire de l'humanité.
Elle a ensuite rencontré un groupe de musulmans, à propos desquels elle déclare : "J'ai rencontré des gens qui ne construisaient pas de statues ou de peintures sensuelles de leur Dieu : "J'ai rencontré des gens qui ne construisaient pas de statues ou de peintures sensuelles de leur Dieu, et quand je leur ai posé la question, ils m'ont répondu que l'islam se méfie beaucoup de l'idolâtrie et du culte des personnes, et qu'il est très facile de connaître Dieu en contemplant ses créations."
Ingrid a commencé son voyage d'apprentissage de l'islam, qui s'est terminé par sa conversion à l'islam, après quoi elle s'est lancée dans un voyage d'apprentissage, puis est entrée dans le domaine du travail missionnaire.
Ses contributions
En 2001, elle a été élue présidente de la Société islamique d'Amérique du Nord, qui compte environ 20 000 membres aux États-Unis et au Canada, ainsi que 350 mosquées et centres islamiques, et Mme Mattson est la première femme à accéder à ce poste dans l'histoire de la Société.
Le chirurgien français Maurice Bucaille
 Qui est Maurice Bucaille ?
Qui est Maurice Bucaille ?
Né de parents français, Maurice Bucaille a été élevé dans la religion chrétienne et, après avoir terminé ses études secondaires, il s'est inscrit à l'université de France pour étudier la médecine. Il a été l'un des premiers à obtenir un diplôme de médecine et sa carrière s'est développée jusqu'à ce qu'il devienne le chirurgien le plus célèbre et le plus compétent que la France moderne ait connu.
L'histoire de l'islam de Maurice Bokay
La France est connue pour être l'un des pays les plus intéressés par l'archéologie et le patrimoine, et lorsque l'ancien président socialiste français François Mitterrand a pris les rênes du pays en 1981, la France a demandé à l'Égypte, à la fin des années 1980, d'accueillir la momie du pharaon égyptien en France pour des tests, des examens et des traitements archéologiques.
Le corps du tyran le plus célèbre d'Egypte a été transporté à l'aéroport, où le président français, ses ministres et les hauts fonctionnaires du pays se sont alignés sur les marches de l'avion pour accueillir royalement le pharaon d'Egypte, comme s'il était encore en vie !
A la fin de la réception royale du Pharaon d'Egypte sur la terre de France, la momie du Léviathan fut transportée dans un cortège à la hauteur de sa réception, et fut transférée dans une aile spéciale du Centre des Antiquités Françaises, après quoi les plus grands archéologues de France, chirurgiens et anatomistes commencèrent à étudier cette momie et à en découvrir les secrets, et le chirurgien en chef et le premier responsable de l'étude de cette momie pharaonique fut le Professeur Maurice Bucaille.
Les guérisseurs sont intéressés par la restauration de la momie, mais leur patron, Maurice Bokay, est tout autre : il cherche à savoir comment est mort ce roi pharaonique, et tard dans la nuit, les résultats définitifs de son analyse sont dévoilés.
Le chirurgien français Maurice Bucaille
Mais ce qui l'intrigue toujours, c'est que ce corps, contrairement aux autres corps pharaoniques momifiés, est resté plus intact que les autres, bien qu'il ait été déterré de la mer.
Maurice Bucaille préparait un rapport final sur ce qu'il pensait être une nouvelle découverte en récupérant le corps de Pharaon dans la mer et en le momifiant juste après sa noyade, lorsque quelqu'un lui a chuchoté à l'oreille : Ne te presse pas, les musulmans parlent de la noyade de cette momie.
Cependant, il a vivement dénoncé cette nouvelle et s'en est étonné, car une telle découverte ne peut être connue que grâce au développement de la science moderne et à l'utilisation d'ordinateurs modernes d'une extrême précision : Leur Coran, auquel ils croient, raconte l'histoire de sa noyade et de la sécurité de son corps après la noyade.
Il est stupéfait et s'interroge : Comment est-ce possible, et cette momie n'a été découverte qu'en 1898, c'est-à-dire il y a près de deux cents ans, alors que leur Coran existe depuis plus de mille quatre cents ans ? presque deux cents ans, alors que leur Coran existe depuis plus de mille quatre cents ans !
Comment cela peut-il être vrai alors que toute l'humanité, et pas seulement les musulmans, ignorait jusqu'à il y a quelques décennies que les Égyptiens de l'Antiquité momifiaient les corps de leurs pharaons ?
Maurice Bucaille est resté assis cette nuit-là à regarder le corps de Pharaon, réfléchissant à ce que son ami lui avait chuchoté sur le fait que le Coran musulman parle de la survie de ce corps après la noyade, alors que la Bible chrétienne (l'Évangile de Matthieu et de Luc) parle de la noyade de Pharaon alors qu'il poursuivait Moïse, sans mentionner du tout le sort de son corps.
Il se dit : "Peut-être que cet homme momifié devant moi est le pharaon d'Égypte qui poursuivait Moïse ? Se pourrait-il que cet homme momifié devant moi soit le pharaon d'Égypte qui poursuivait Moïse ?
Est-il possible que Muhammad l'ait su il y a plus de mille ans et que je l'apprenne seulement maintenant ?
Maurice Bucay n'arrivait pas à dormir et demanda qu'on lui apporte la Torah, il lut alors dans le livre de l'Exode dans la Torah : Maurice Bucaille resta perplexe : "L'eau revint et couvrit les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui les poursuivait dans la mer, et il n'en resta pas un seul".
Même la Torah ne parle pas de ce corps qui aurait survécu et serait resté intact après que le corps de Pharaon ait été traité et restauré.
La France rend la momie à l'Egypte dans un luxueux cercueil de verre, mais Maurice Bucaille n'a pas l'esprit tranquille car il est ébranlé par les nouvelles diffusées par les musulmans sur la sécurité de ce corps ; il fait ses bagages et décide de se rendre en Arabie Saoudite pour assister à une conférence médicale où se trouve un groupe d'anatomistes musulmans.
L'un d'eux se leva, ouvrit le Coran et commença à lui lire le verset suivant : {Aujourd'hui, nous te livrons avec ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi, et que beaucoup d'hommes ignorent nos signes [Yunus : 92].
L'impact du verset sur lui a été très fort et il a été tellement secoué qu'il s'est levé devant l'auditoire et a crié à tue-tête : "Je suis entré dans l'islam et je crois en ce Coran" : "Je suis entré dans l'islam et je crois en ce Coran.
Contributions de Maurice Bucaille
Maurice Bucaille revint en France par un autre chemin que celui qu'il avait emprunté, et il y resta pendant dix ans sans rien faire d'autre que d'étudier la concordance entre les faits scientifiques nouvellement découverts et le Saint Coran, et de rechercher une seule contradiction scientifique dans le Coran pour aboutir au résultat des paroles du Tout-Puissant : {Aucun mensonge ne peut venir d'entre ses mains ou derrière lui, une révélation d'un juge sage et bon} [Faslat : 42].
Le fruit de ces années passées par le Français Maurice Bucaille fut un livre sur le Saint Coran qui ébranla tous les pays occidentaux et leurs savants : "Le Coran, la Torah, la Bible et la Science. Une étude des Saintes Écritures à la lumière des connaissances modernes". Qu'a fait ce livre ?
Lors de sa première impression, il a été épuisé dans toutes les librairies ! Il a ensuite été réimprimé par centaines de milliers après avoir été traduit de sa langue originale (le français) en arabe, en anglais, en indonésien, en persan, en turc et en allemand, puis diffusé dans toutes les bibliothèques d'Orient et d'Occident, et vous pouvez le trouver entre les mains de n'importe quel jeune Égyptien, Marocain ou du Golfe en Amérique.
Les érudits juifs et chrétiens qui ont eu le cœur et les yeux bloqués par Dieu ont essayé de répondre à ce livre, mais ils n'ont écrit que des absurdités polémiques et des tentatives désespérées dictées par les murmures de Satan, le dernier en date étant le Dr William Campbell dans son livre intitulé "The Qur'an and the Bible in the Light of History and Science" (Le Coran et la Bible à la lumière de l'histoire et de la science).
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que certains érudits occidentaux ont commencé à préparer une réponse à ce livre et que, lorsqu'il s'est plongé dans sa lecture et sa réflexion, il s'est converti à l'islam et a proclamé la Shahadah en public !
Maurice Bucaille Citations
Maurice Bucaille déclare dans l'introduction de son livre : "Ces aspects scientifiques du Coran ont d'abord suscité mon profond étonnement. Je n'avais jamais pensé qu'il était possible de découvrir autant d'exactitude sur des sujets aussi divers, et leur conformité totale avec les connaissances scientifiques modernes, dans un texte écrit il y a plus de treize siècles."
Il dit aussi : "J'ai d'abord étudié le Coran, sans aucune idée préconçue et en toute objectivité, en recherchant le degré de concordance entre le texte du Coran et les données de la science moderne. Avant cette étude, je savais, grâce à des traductions, que le Coran mentionnait de nombreux types de phénomènes naturels, mais ma connaissance était sommaire.
Grâce à une étude minutieuse du texte arabe, j'ai pu dresser une liste, après quoi je me suis rendu compte que le Coran ne contenait aucune affirmation critiquable du point de vue de la science moderne et, avec la même objectivité, j'ai procédé au même examen de l'Ancien Testament et des Évangiles.
Quant à l'Ancien Testament, il n'était pas nécessaire d'aller plus loin que le premier livre, la Genèse, car il contient des affirmations qui ne peuvent être conciliées avec la science la plus établie de notre époque.
Quant aux Évangiles, nous constatons que le texte de l'Évangile de Matthieu contredit clairement celui de l'Évangile de Luc, et que ce dernier présente explicitement quelque chose qui n'est pas conforme aux connaissances modernes sur l'âge de l'homme sur terre".
Le Dr Maurice Bucaille déclare également "La première chose qui suscite l'étonnement dans l'âme de ceux qui rencontrent les textes du Coran pour la première fois, c'est la richesse des sujets scientifiques traités, alors que dans la Torah - aujourd'hui - on trouve d'énormes erreurs scientifiques, on ne découvre aucune erreur dans le Coran, et si l'auteur du Coran était un être humain, comment aurait-il pu, au VIIe siècle, écrire des faits qui n'appartiennent pas à son époque ?".
En 1988, l'Académie française lui a décerné son prix d'histoire pour son livre Le Coran et la science moderne.
Le scientifique américain Jeffrey Lang
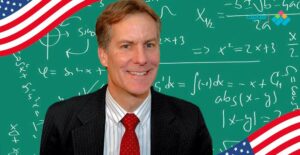 Présentation
Présentation
Le mathématicien américain Jeffrey Lang est né à Bridgeport, dans le Connecticut, en 1954. Il a obtenu son doctorat à l'université de Purdue et est actuellement professeur au département de mathématiques de l'université du Kansas.
Rejeter le christianisme
Dans son livre The Struggle for Faith, Jeffrey Lange raconte son expérience dramatique, qui vaut la peine d'être racontée pour que les gens se fassent une idée de la propagation de l'islam en Occident et de la manière dont elle se produit.
L'homme a grandi dans une famille chrétienne et lorsque le professeur de religion a essayé de prouver l'existence de Dieu à l'aide des mathématiques, Jeffrey Lange, qui était lycéen, s'est disputé avec lui au sujet des preuves ; le professeur s'est agacé et l'a renvoyé de la classe avec un avertissement.
Le jeune homme rentra chez lui, et lorsque ses parents entendirent l'histoire, ils furent choqués et dirent : "Tu es devenu athée, mon fils.
Lang dit : "Il a perdu la foi dans le christianisme occidental." Lang est resté dans cet état d'athéisme pendant dix ans, en cherchant, mais ce qui le dérangeait le plus, c'était le malheur des gens en Europe, malgré leur vie luxueuse.
Son histoire avec l'islam
En un clin d'œil, la surprise est venue sous la forme d'un cadeau d'une famille saoudienne, et Lang décrit le Coran comme suit :
"J'avais l'impression d'être en face d'un professeur de psychologie qui éclairait tous mes sentiments cachés. J'essayais de discuter de certains problèmes et je découvrais qu'il était juste en face de moi, plongeant dans mes profondeurs et me mettant à nu devant la vérité."
Il s'est converti à l'islam en 1980 après avoir été athée.
Shoji Futaki. Le médecin japonais
 L'islam de Shoji Fotaki marque un tournant dans l'histoire du Japon, voire de toute l'Asie du Sud-Est. Quelle est l'histoire de la conversion du médecin japonais Shoji Fotaki ? Le médecin japonais
L'islam de Shoji Fotaki marque un tournant dans l'histoire du Japon, voire de toute l'Asie du Sud-Est. Quelle est l'histoire de la conversion du médecin japonais Shoji Fotaki ? Le médecin japonais
Votaki est un médecin japonais qui s'est converti à l'islam à l'âge de soixante-sept ans, avec une personnalité sociale attachante et charismatique, influençant tous ceux qui entrent en contact avec lui. Sa religion avant l'islam était le bouddhisme, et il était le directeur d'un grand hôpital au cœur de Tokyo (la capitale du Japon), et cet hôpital était une société par actions appartenant à dix mille personnes, et le Dr Votaki a annoncé depuis son islam qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour amener les dix mille actionnaires dans le giron de l'islam.
Outre son travail de directeur d'hôpital, le Dr Futaki a été rédacteur en chef d'un magazine mensuel japonais intitulé Sekami Jeep en 1954. Il s'est intéressé à la question de la bombe atomique larguée sur le Japon et à son impact, et a tenté de collecter des fonds pour ce projet. Ayant échoué, il a soutiré soixante millions de yens japonais à dix entreprises japonaises après les avoir menacées de publier des informations secrètes affectant leurs intérêts, et après de longs procès, il a été condamné à trois ans de prison et s'est vu retirer son autorisation d'exercice de la médecine.
Histoire de l'Islam
Il commence à lire plusieurs ouvrages philosophiques, politiques et spirituels. L'idée du monothéisme commence à interagir avec lui, et cette idée prend racine lorsqu'il entre en contact avec plusieurs personnalités islamiques, dont un musulman nommé Abu Bakr Mori Muto, ancien président de l'Association japonaise des musulmans, qui lui disait : "Plus il y aura de musulmans dans le monde, plus le problème des laissés-pour-compte de la terre prendra fin, car l'islam est une religion d'amour et de fraternité."
Après avoir trouvé des conseils dans l'islam, Futaki, son fils et un autre ami ont décidé de se convertir à l'islam et ont déclaré leur foi au centre islamique de Tokyo.
Contributions
L'islam de Shoji Futaki a marqué l'islamisation de tout le Japon. Mais pourquoi son islam constitue-t-il une transformation majeure au Japon ?
Après son islamisation, en mars 1975, il est venu à la tête de soixante-huit personnes pour déclarer leur islam à la mosquée de Tokyo, et il a également créé l'Association de la Fraternité islamique.
En outre, le 4/4/1975, la mosquée de Tokyo a accueilli deux cents Japonais qui ont déclaré leur appartenance à l'islam, et c'est ainsi que le Dr Shoji Futaki a commencé à amener ses frères japonais à entrer en masse dans la religion de Dieu, jusqu'à ce que le nombre de membres de l'Association de la Fraternité islamique, qu'il dirigeait à partir de ces nouveaux musulmans, atteigne près de vingt mille musulmans japonais, et ce en moins d'un an.
L'islam de Shoji Futaki marque un tournant dans l'histoire du Japon, voire de toute la région de l'Asie du Sud-Est.
Cependant, un phénomène est apparu parmi ceux qui ne connaissent pas la langue arabe et ne vivent pas dans des pays musulmans, à savoir certaines impuretés provenant de l'influence de la jahiliyyah ; le Dr Shawki Futaki a été indulgent avec les nouveaux musulmans de son association islamique sur la question de l'interdiction du porc et de la consommation d'alcool, peut-être a-t-il des excuses pour son ignorance, et peut-être voulait-il les amener progressivement à agir. C'est pourquoi les pays islamiques, en particulier les pays arabes, devraient envoyer des prédicateurs dans ces pays (2).
La source : Le livre du Dr Ragheb al-Sarjani (Grands hommes devenus musulmans).
Douglas Archer
L'histoire du Dr Douglas Archer, directeur de l'Institut d'éducation de la Jamaïque Quelle est l'histoire de la conversion à l'islam du Dr Douglas Archer ? L'islam est une religion unique
Douglas Archer, dont le nom islamique est Abdullah, était le directeur de l'Institut éducatif de la Jamaïque. Avant de se convertir à l'islam, il était protestant adventiste du septième jour et a également travaillé à l'université de l'Illinois aux États-Unis.
L'histoire de Douglas Archer
Son histoire avec l'islam a commencé lorsqu'il donnait des cours de psychologie à l'université et qu'il y avait des étudiants musulmans qui ne parlaient pas bien l'anglais, de sorte qu'il a dû s'asseoir avec eux après les cours.
Son intérêt pour l'islam s'explique en grande partie par l'étude de la philosophie, qui lui a permis de se familiariser avec l'islam.
L'une des choses qui l'a amené à connaître l'islam de plus près est un étudiant saoudien du département de troisième cycle qui vivait près de chez lui, qui lui a beaucoup parlé de l'islam, lui a donné de nombreux livres islamiques et l'a présenté à deux professeurs musulmans de l'université.
Quant à l'élément clé qui l'a conduit à l'islam, il a déclaré :
"Un autre point important est que ma recherche doctorale portait sur l'éducation et la construction de la nation, et j'ai ainsi appris ce dont les nations ont besoin pour leur construction sociale, économique et politique, ainsi que pour leur construction spirituelle. J'ai découvert que les piliers fondamentaux de l'islam constituaient une base solide et précieuse pour la reconstruction sociale, économique et spirituelle de la nation ; par conséquent, si vous me demandez : "Pourquoi me suis-je converti à l'islam ? Pourquoi me suis-je converti à l'islam ? Parce que l'islam est une religion unique dont les piliers fondamentaux forment une règle de jugement qui guide à la fois la conscience et la vie de ses croyants.
Contributions de Douglas Archer
Douglas Archer a défendu l'Islam et a déclaré : Il est capable de résoudre les problèmes et de répondre aux besoins sociaux, spirituels et politiques de ceux qui vivent sous le capitalisme et le communisme ; ces deux systèmes n'ont pas réussi à résoudre les problèmes humains, alors que l'Islam offrira la paix aux malheureux et l'espoir et l'orientation aux perdus et aux désorientés.
Le Dr Douglas Archer, à travers sa présidence de l'Institut éducatif des Caraïbes, tente également de répandre l'islam dans les Antilles par le biais des programmes scientifiques de l'institut, et a effectué une tournée en Arabie Saoudite et au Koweït pour soutenir sa cause islamique.
La source : Le livre du Dr Ragheb al-Sarjani (Grands hommes devenus musulmans).
David Lively
 L'histoire de l'Américain David Lively, dont l'esprit et le cœur ne pouvaient accepter deux des principaux principes du christianisme : les doctrines de la Trinité et du salut. Quelle est l'histoire de la conversion de David ?
L'histoire de l'Américain David Lively, dont l'esprit et le cœur ne pouvaient accepter deux des principaux principes du christianisme : les doctrines de la Trinité et du salut. Quelle est l'histoire de la conversion de David ?
David Lively est né à Philadelphie, dans le nord-est des États-Unis, et a étudié les mathématiques jusqu'à l'obtention d'un diplôme en informatique à l'université de Lehigh.
Il parle de lui en ces termes : "Dans ma jeunesse, ma famille et moi avons fréquenté une église protestante : "Le protestantisme est la doctrine de la majorité du peuple américain, et j'ai été exposé très tôt à des textes religieux et à des croyances, mais j'ai remarqué que mon esprit et mon cœur n'acceptaient pas deux croyances chrétiennes fondamentales, à savoir :
- La doctrine de la triangulation (rejetée sous toutes ses formes) en raison de sa contradiction avec la raison.
- La doctrine du salut attribuée à Jésus-Christ, paix sur lui, en raison de sa contradiction religieuse dans le domaine de l'éthique.
À cette époque, je me suis précipité à la recherche d'une nouvelle croyance qui me protégerait de la déviation et de la perte, et qui comblerait le vide spirituel dont souffrent et se plaignent les jeunes Américains et Européens.
L'histoire de David Lively
À propos de lui-même, David Lively a déclaré
"J'ai été présenté à un ami américain qui m'a précédé dans l'Islam, et il avait une traduction des significations du Saint Coran en anglais, alors je l'ai prise pour l'ajouter à mes livres religieux, et dès que j'ai commencé à la lire, mon cœur a été réconforté par les principes que l'Islam inclut, et alors je me suis tourné vers l'Islam, priant Allah avec ces supplications : Ô Maître de la guidance, si cette religion appelée islam n'est pas ta vraie religion dont tu es satisfait, éloigne-moi d'elle et de mes coreligionnaires, et si c'est ta vraie religion, rapproche-moi d'elle et éclaire-moi en elle.
Il ne se passait pas une semaine sans que l'islam ne s'installe dans mon cœur et ne prenne racine dans ma conscience, de sorte que mon cœur et mon esprit étaient tranquilles et mon âme paisible, et je me suis reposé sur le fait que l'islam est vraiment la religion de Dieu, et que le Coran dit vrai lorsqu'il affirme : {La religion de Dieu est l'islam} [Al-Imran : 19]".
Contributions de David Lively
Dawud Abdullah al-Tawhidi (c'est son nom après l'Islam) a essayé d'alerter les musulmans sur leur situation, en leur demandant de changer leur situation :
"Quelle différence entre l'Islam et les valeurs, la morale et l'éthique qu'il englobe, et l'état d'ignorance des musulmans quant à leur foi, leur perte de valeurs et leur éloignement des valeurs et de l'éthique de l'Islam ! Les gouvernants musulmans ont tardé à œuvrer pour l'islam, alors que c'est leur mission suprême, et les savants islamiques ont abandonné leur véritable rôle dans la da'wah, l'ijtihad et la déduction des jugements. Ce qui est demandé aux savants islamiques, c'est non seulement de préserver l'héritage, mais aussi de revenir à la mise en œuvre de la pensée islamique, et alors la lumière de la prophétie, de la foi, de l'application et du bénéfice pour autrui leur reviendront.
Il est surprenant que de nombreux jeunes du monde musulman s'éloignent des valeurs spirituelles de l'islam et de ses enseignements, alors que les jeunes du monde occidental ont soif de ces valeurs, mais ne les trouvent pas dans leurs sociétés laïques, qui ne connaissent rien à l'islam".
Quant au souhait de ce musulman américain, Daoud al-Tawhidi :
"Mon souhait est de poursuivre mes études islamiques et de me spécialiser dans le domaine des religions comparées afin de participer à l'éducation des futures générations de musulmans en Amérique, de contrer l'invasion intellectuelle et de répandre l'islam parmi les non-musulmans. J'espère également qu'un jour viendra où je verrai l'Islam avoir un impact sur la future refonte de la société américaine, et que je participerai à la renaissance de l'Islam dans le monde entier ; car l'Islam ne connaît pas de nationalités, mais est une guidance envoyée au monde, et le Saint Coran dit du Messager de l'Islam : {Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour le monde} [Al-Anbiya : 107].
La source : Le livre du Dr Ragheb al-Sarjani (Grands hommes devenus musulmans).
Le scientifique hongrois Abdul Karim Germanius
 L'histoire retiendra l'orientaliste (Golager Manius) comme l'une des personnes célèbres qui se sont converties à l'islam dans l'État de Hongrie.
L'histoire retiendra l'orientaliste (Golager Manius) comme l'une des personnes célèbres qui se sont converties à l'islam dans l'État de Hongrie.
Présentation
Gulager Manius est né le 6 novembre 1884. Après son entrée dans l'islam, il s'est donné un nom islamique, Abdulkarim Germanius.
Abdulkarim Germanius a pu prêcher l'islam et le message mahométan dans le cadre de son travail, en tant que professeur à l'Université Laurentienne. Abdulkarim Germanius a été suivi par un grand nombre de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'université, à tel point que l'université a créé une chaire d'histoire arabe et islamique au nom d'Abdulkarim Germanius.
Son histoire avec l'islam
Le Dr Abdul Karim Germanius raconte l'histoire de sa conversion à l'islam : "C'était un après-midi pluvieux, j'étais encore adolescent et je feuilletais les pages d'un vieux magazine illustré, mêlant des événements d'actualité à des histoires fictives, avec des descriptions de pays lointains ; je feuilletais les pages avec indifférence depuis un certain temps jusqu'à ce que mes yeux tombent soudain sur l'image d'un panneau de bois sculpté qui a attiré mon attention, l'image représentait des maisons aux toits plats entrecoupés ici et là de dômes ronds qui s'élevaient doucement vers le ciel sombre dont l'obscurité était rompue par le croissant de lune.
L'image a captivé mon imagination et j'ai ressenti un désir irrésistible de connaître cette lumière qui surmontait l'obscurité dans le tableau. J'ai commencé à étudier le turc, puis le persan, puis l'arabe, et j'ai essayé de maîtriser ces trois langues pour pouvoir entrer dans ce monde spirituel qui répandait cette lumière éblouissante dans l'humanité".
Lors de vacances d'été, j'ai eu la chance de me rendre en Bosnie - le pays oriental le plus proche de mon pays - et dès que je me suis installée à l'hôtel, je me suis précipitée pour voir les musulmans dans leur vie réelle, d'où je suis ressortie avec une impression différente de ce que l'on dit sur les musulmans, et ce fut ma première rencontre avec les musulmans. Des années et des années ont passé dans une vie pleine de voyages et d'études, et chaque jour qui passait, mes yeux s'ouvraient à de nouveaux et merveilleux horizons.
Bien qu'il ait beaucoup voyagé dans le monde de Dieu, qu'il ait apprécié les merveilles archéologiques de l'Asie mineure et de la Syrie, qu'il ait appris de nombreuses langues et qu'il ait lu des milliers de pages de livres savants, il a lu tout cela d'un œil attentif : "Malgré tout cela, mon âme est restée assoiffée.
Alors qu'il était en Inde, il vit une nuit - comme le voit un dormeur - que Muhammad, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, s'adressait à lui d'une voix compatissante : "Pourquoi es-tu perplexe ? Le chemin droit qui s'offre à toi est aussi sûr et pavé que la surface de la terre. Marche d'un pas ferme et avec la force de la foi." Le vendredi suivant, le grand événement eut lieu à la Juma Masjid de Delhi, lorsqu'il professa l'islam devant des témoins.
Hajj Abdulkarim Jarmanous se souvient de ces moments d'émotion : "Les pauvres gens fatigués me regardaient en suppliant, demandant des prières et voulant embrasser ma tête. J'ai prié Dieu de ne pas laisser ces âmes innocentes me regarder comme si j'étais supérieur à elles, car je ne suis qu'un insecte parmi les insectes de la terre, ou un vagabond à la recherche de la lumière, sans défense comme d'autres créatures malheureuses, et j'avais honte devant les gémissements et les espoirs de ces bonnes gens. Le lendemain et le surlendemain, les gens sont venus en masse pour me féliciter, et j'ai reçu d'eux assez d'amour et d'affection pour toute ma vie.
Passion pour l'apprentissage des langues
Abdulkarim Germanos a appris les langues occidentales : le grec, le latin, l'anglais, le français, l'italien, le hongrois et les langues orientales : Persan et Urdu, et maîtrise l'arabe et le turc auprès de ses professeurs : Vampyre et Goldziher, dont il hérite son goût pour l'Orient islamique. Il poursuit ses études après 1905 aux universités d'Istanbul et de Vienne : Istanbul et Vienne. Il écrit un livre en allemand sur la littérature ottomane en 1906, et un autre sur l'histoire des variétés turques au XVIIe siècle, pour lequel il reçoit un prix qui lui permet de faire un séjour prolongé à Londres, où il achève ses études au British Museum.
En 1912, il retourne à Budapest et est nommé professeur d'arabe, de turc et de persan, d'histoire et de culture de l'islam au lycée oriental, puis au département oriental de l'université économique, puis professeur et directeur du département d'arabe à l'université de Budapest en 1948, où il continue d'enseigner la langue arabe, l'histoire de la civilisation islamique et la littérature arabe ancienne et moderne, en essayant de trouver des liens entre le renouveau social et psychologique des nations islamiques, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 1965.
Le poète indien Tagore l'invite en Inde à travailler comme professeur d'histoire islamique, qu'il enseigne dans les universités de Delhi : (1929-1932 ap. J.-C.), où il déclare son islam dans la grande mosquée de Delhi, prononce le sermon du vendredi et prend le nom d'Abdul Karim. Il se rend au Caire et étudie l'islam avec les cheikhs d'Al-Azhar, puis se rend à La Mecque en tant que pèlerin, visite la mosquée du Prophète (sur lui la paix) et écrit son livre sur son pèlerinage : Allahu Akbar, qui a été publié dans le monde entier : Allahu Akbar, publié en plusieurs langues en 1940, et a mené des recherches scientifiques (1939-1941) au Caire et en Arabie saoudite, dont il a publié les résultats en deux volumes : Shawamekh al-Adab al-Arabi, 1952, et Studies in Arabic Linguistic Structures, 1954.
Au printemps 1955, il retourne passer quelques mois au Caire, à Alexandrie et à Damas, à l'invitation du gouvernement, pour donner des conférences en arabe sur la pensée arabe contemporaine.
Ses contributions
Le Dr Abdulkarim Jarmanous a laissé un riche héritage scientifique caractérisé par la profondeur et la diversité : La grammaire de la langue turque (1925), La révolution turque, le nationalisme arabe (1928), La littérature turque moderne (1931), Les courants modernes de l'islam (1932), La découverte et la conquête de la péninsule arabique, de la Syrie et de l'Irak (1940), La renaissance de la culture arabe (1944) et Les études sur les structures de la langue arabe (1954). (1944), Études sur les structures de la langue arabe (1954), Ibn al-Rumi (1956), Parmi les penseurs (1958), Vers les lumières de l'Orient, Poètes arabes choisis (1961), Culture islamique, Littérature du Maghreb (1964), et il prépare trois ouvrages sur : la littérature hijra, les voyageurs arabes et Ibn Battuta, et l'histoire de la littérature arabe.
Ce professeur hongrois, grâce à ses études connues dans le monde arabe, a contribué à la diffusion de l'appel islamique et à la création d'une célèbre bibliothèque islamique en collaboration avec le cheikh égyptien Abu Yusuf. Le gouvernement hongrois s'est occupé de cette bibliothèque, qu'il finance encore aujourd'hui afin de préserver l'héritage et l'histoire islamiques et d'encourager les musulmans.
Il a eu l'occasion de faire un voyage dans le désert en 1939 après les aventures passionnantes qu'il a rencontrées en traversant la mer vers l'Égypte, en visitant le Liban et la Syrie, puis en effectuant son deuxième pèlerinage. Dans l'introduction de l'édition 1973 de Dieu est grand, il écrit ce qui suit : "J'ai visité trois fois la péninsule, La Mecque et Médine, et j'ai publié dans mon livre (Allahu Akbar !) les expériences que j'ai vécues lors de mon premier voyage. En 1939-1940, après le début de la Seconde Guerre mondiale, j'ai traversé le Danube pour atteindre la mer en tant que marin, sans me soucier des dangers et de la fatigue. J'ai atteint l'Égypte et de là, j'ai navigué vers la péninsule. J'ai passé plusieurs mois à Médine, où j'ai visité les lieux liés à la vie du Prophète (PBUH) : Les ruines de la mosquée Qiblatain, le cimetière de Baqi'a et les sites des batailles de Badr et Uhud. J'étais l'invité de la mosquée égyptienne fondée par Muhammad Ali dans la ville. Le soir, des érudits musulmans me rendaient visite pour parler de l'état de l'islam dans le monde. Comme je l'explique dans mon livre, j'ai ressenti chez eux l'esprit de l'islam, toujours aussi fort et profond, malgré tous les changements dans le monde, tout comme j'en avais fait l'expérience dans ma jeunesse dans l'Orient musulman". Son rêve d'aller du Hejaz à Riyad avec les caravanes s'est réalisé au cours du voyage de 1939, et il a atteint Riyad après quatre semaines difficiles, dont il a immortalisé les détails dans son célèbre livre (Under the Faint Light of the Crescent Moon) en 1957.
Dans son livre suivant, Towards the Lights of the East (1966), il présente ses expériences au cours de ses voyages entre 1955 et 1965. En 1962, il se rend à Bagdad à l'invitation du Premier ministre Abd al-Karim Qasim pour participer aux célébrations organisées à l'occasion du 1200e anniversaire de la fondation de Bagdad. Il devient alors membre du Conseil scientifique irakien et présente, lors de la cérémonie d'inauguration, un document intitulé : "L'histoire de l'islam en Hongrie" : L'histoire de l'islam en Hongrie. En 1964, le gouvernement égyptien l'invite à participer à la célébration du millénaire de la fondation d'Al-Azhar et, en 1965, le roi Fayçal bin Saud l'invite à assister à la Conférence islamique de La Mecque, où il accomplit le Hajj pour la troisième fois, dans sa quatre-vingt-unième année.
Il a écrit sur l'histoire et la littérature des Turcs ottomans, a fait des recherches sur les développements contemporains de la République turque, sur l'Islam et les courants intellectuels islamiques contemporains, et sur la littérature arabe. Il a publié un livre important intitulé (Histoire de la littérature arabe) en 1962, et avant cela (Poètes arabes de la Jahiliyya à nos jours) en 1961, il a écrit sur les voyageurs et les géographes arabes (Arab Geographers, Londres 1954), et il a fait de nombreuses études sur l'Inde. Il a écrit ses livres et ses recherches dans plusieurs langues, outre le hongrois, comme l'anglais, le français, l'italien et l'allemand : L'anglais, le français, l'italien et l'allemand. Germanos a donc joué un rôle de pionnier dans l'introduction de la culture arabe, de la littérature arabe, de l'Islam et de la civilisation orientale en général, et des générations successives de Hongrois ont appris à connaître et à aimer ses œuvres.
Sa mort
Abdulkarim Germanus est décédé le 7 novembre 1979, à l'âge de 96 ans, et a été enterré selon les rites islamiques dans un cimetière de Budapest. Le musée géographique hongrois de la ville d'Erd conserve l'intégralité des archives de ce voyageur et orientaliste hongrois musulman.
Emile Brice-Davin. Monde des civilisations et de l'archéologie
Emile presse Daphné a été l'un des plus influents parmi ses contemporains français qui ont étudié l'Egypte, d'autant plus qu'il était un personnage distingué et polyvalent ; il ne s'est pas contenté de découvrir les antiquités pharaoniques, mais il est allé au-delà pour étudier la civilisation islamique. L'audace de ses découvertes et la témérité de ses aventures témoignent de sa perspicacité, de son sens de l'observation, de l'étendue de ses connaissances et de son désir d'atteindre la vérité.
Il a enrichi l'archéologie de travaux extrêmement importants, auxquels il a consacré de nombreuses années d'efforts continus, sacrifiant une grande fortune dont il avait hérité, en plus des postes qu'il occupait, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de présenter quatorze livres, en plus d'articles et d'études, dont les plus importants sont son livre (Antiquités égyptiennes et histoire de l'art égyptien de l'aube de l'histoire à la domination romaine) et son énorme encyclopédie (L'art arabe de l'archéologie de l'Égypte du septième siècle à la fin du dix-huitième siècle).
Les exploits et les réalisations d'Emile Davin constituent des œuvres dignes de reconnaissance et son nom devrait briller aux côtés de ceux de Champollion, Mariette et Maspero dans la mémoire des amateurs d'histoire de l'art.
En 1829, Brice Davin entre comme ingénieur civil au service d'Ibrahim Pacha, puis comme professeur de topographie à l'école Arkan Harb de la Khanqah, et comme éducateur des enfants du Pacha. Mais son arrogance, son orgueil et sa réprobation des comportements répréhensibles l'amènent souvent à s'irriter et à se montrer imprudent avec ses supérieurs au point de les agresser, ce qui lui attire les foudres de ces derniers jusqu'à ce que l'incident finisse par provoquer la colère du gouverneur à son égard.
L'ingénieur devient rapidement orientaliste et égyptologue, apprenant l'arabe, ses dialectes et ses intonations, et déchiffrant les hiéroglyphes. Ayant pris conscience de sa capacité d'indépendance, il démissionne de son poste en 1837, préférant sa liberté de voyageur, d'explorateur et d'archéologue.
L'histoire de l'islam d'Emile Brice-Davin
Emile Brice-Davin a étudié l'Islam avec soin, en commençant par le Coran, la vie du Prophète de l'Islam et son appel, et comment les Arabes n'étaient que des tribus rivales qui se battaient les unes contre les autres, et comment le Prophète a pu en faire une nation unifiée qui a vaincu les deux plus grands empires du monde : L'Empire perse et l'Empire byzantin, et leur soumission à l'autorité musulmane.
Il explique pourquoi il est devenu musulman :
Il a rappelé que la loi de l'Islam se caractérise par la justice, la vérité, la tolérance et le pardon, qu'elle appelle à la pleine fraternité humaine, qu'elle prône toutes les vertus et interdit tous les vices, et que la civilisation islamique est une civilisation humanitaire qui a prévalu dans le monde antique pendant des siècles.
Emile Davin étudie tout cela et son cœur et son esprit le poussent à embrasser l'islam. Il se convertit donc à l'islam, prend le nom d'Idris Davin, s'habille en paysan et part accomplir sa mission en Haute-Égypte et dans le Delta.
Contributions d'Emile Brice-Davin
Les Arabes doivent beaucoup plus à Bryce Davin dans le domaine de l'archéologie islamique que dans celui de l'archéologie pharaonique.
Le savant des civilisations et de l'archéologie, Idris Davin, a su sortir de leur sommeil les civilisations pharaonique et islamique, et nous rendre l'art humaniste arabe vivant et accessible, ce que l'Islam doit à cet orientaliste franco-musulman.
La source : Le livre du Dr Ragheb al-Sarjani (Grands hommes devenus musulmans).
Christopher Chamont
L'un des économistes les plus célèbres au monde, il s'est converti à l'islam et a changé son nom de Christopher Hamont en Ahmed.
Mais qu'est-ce qui a poussé le célèbre économiste à se convertir à l'islam ? C'est ce que nous allons découvrir à travers son histoire de l'islam.
L'histoire de Christopher Chamont
L'histoire de l'islam de Christopher Chamont a commencé lorsqu'il a commencé à douter de l'histoire de la triangulation, pour laquelle il n'a pas trouvé d'explication convaincante, sauf dans le Coran. Il a trouvé son chemin vers l'islam, a compris sa nature et sa grandeur, et a trouvé ce qu'il cherchait sur le processus de triangulation lorsqu'il a lu dans le Coran que Jésus (que la paix soit sur lui) est un messager de Dieu, qu'il est humain, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est digne d'adoration et d'obéissance.
Christopher Chamont a commencé à en apprendre davantage sur l'Islam en lisant le Saint Coran traduit en anglais, ainsi que des livres traduits sur l'Islam, car il travaillait en Arabie Saoudite et cela lui a donné l'occasion de rencontrer des musulmans de différentes nationalités :
"Mes interactions et discussions avec des musulmans de différentes nationalités ont eu un impact considérable sur ma connaissance de l'islam, car je me suis sentie poussée à vouloir en apprendre davantage sur la philosophie de l'islam.
C'est ainsi que Christopher Chamont a connu l'islam, qu'il a trouvé la vérité qu'il cherchait et qu'il s'y est tenu malgré sa notoriété d'économiste parmi les plus renommés au monde.
Contributions de Christopher Chamont
Christopher Chamont a appelé les musulmans à adhérer aux enseignements de leur religion, car c'est la raison de leur succès :
"Les enseignements de l'islam sont formidables et si les musulmans y adhéraient, ils atteindraient les plus hauts niveaux de progrès, de puissance et de civilisation, mais les musulmans sont repliés sur eux-mêmes, ce qui fait que d'autres les dépassent, bien que les premiers musulmans aient été les premiers à suivre la voie de la civilisation et du progrès scientifique, social et économique".
Christopher Chamont a démontré que les enseignements de l'islam sont la voie du progrès et de l'avancement, que le manque d'adhésion à ces enseignements est la raison du retard des musulmans, et que le retour des musulmans à leur culte est la clé de leur progrès et de leur réussite.
Ahmed Chamont a également parlé de l'Islam, en disant :
"L'islam est la religion qui s'adresse à l'esprit de l'homme et met sa main au début du chemin qui mène au bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. J'ai trouvé dans l'islam ce que je cherchais, et toute question à laquelle l'homme est confronté peut trouver sa solution dans le Saint Coran".
La source : Le livre du Dr Ragheb al-Sarjani (Grands hommes devenus musulmans).
L'orientaliste Hussein Ruf. Religion et sociologue
Né en 1916 de parents chrétiens et juifs en Angleterre, M. Rove, orientaliste et sociologue anglais, a commencé par étudier la foi de ses parents chrétiens et juifs. Il a ensuite étudié l'hindouisme et sa philosophie, en particulier ses enseignements modernes, ainsi que la doctrine bouddhiste, en la comparant à certaines doctrines grecques anciennes, puis il a étudié certaines théories et doctrines sociales modernes, en particulier les idées du grand scientifique et philosophe russe Léon Tolstoï.
L'histoire de l'islam de l'orientaliste Hussein Ruf
L'intérêt de M. Ruf pour l'islam et son étude de l'islam ont été tardifs par rapport aux autres religions et croyances, malgré son séjour dans certains pays arabes ; son premier contact avec l'islam a été la lecture d'une traduction du Saint Coran réalisée par Rodwell, mais il n'a pas été influencé par cette traduction parce qu'elle n'était pas fidèle et honnête, comme de nombreuses traductions similaires, entachées d'ignorance ou de desseins hostiles, qui ont été publiées dans plusieurs langues étrangères.
Cependant, heureusement pour lui Il a rencontré un défenseur instruit et sincère de l'islam, passionné par cette religion et désireux de la faire connaître, qui lui a présenté certains faits relatifs à l'islam et l'a guidé vers l'une des versions traduites des significations du Saint Coran, traduite par un érudit musulman, à laquelle il a ajouté une explication claire et convaincante fondée sur la logique et la raison, tout en clarifiant les véritables significations que la langue anglaise n'est pas en mesure d'exprimer. Il l'a également guidé vers d'autres livres islamiques caractérisés par la sincérité et la clarté des preuves, ce qui lui a permis de se faire une première idée de la vérité de l'islam et a éveillé son désir d'approfondir sa connaissance de l'islam, de ses principes et de ses objectifs par le biais de sources scientifiques exemptes de préjugés.
Ses contacts avec certains groupes islamiques et son étude approfondie de leurs conditions ont confirmé l'étendue de l'influence de l'Islam sur leur comportement et leurs associations ; cela a confirmé son idée initiale de la grandeur de l'Islam, et il y a cru pleinement.
Pourquoi cet orientaliste anglais est-il devenu musulman ?
Il décrit son expérience de conversion à l'islam :
"Un jour de 1945, j'ai été invité par des amis à assister aux prières de l'Aïd et à manger après les prières, ce qui a été pour moi une bonne occasion de voir de près cette foule internationale de musulmans, sans fanatisme national ou racial... J'y ai rencontré un prince turc et, à côté de lui, de nombreux indigents, tous assis à table, et l'on ne voit pas sur le visage des riches une humilité artificielle ou un faux semblant d'égalité, comme l'homme blanc lorsqu'il parle à son voisin noir, et l'on ne voit pas non plus parmi eux ceux qui se retirent de la congrégation ou se déplacent sur un côté ou dans un coin éloigné, ni ce ridicule sentiment de classe qui peut se cacher derrière de faux rideaux de vertu".
"Il me suffit de le dire après réflexion et contemplation : Après avoir étudié toutes les autres religions connues dans le monde, je me suis trouvé spontanément guidé à croire en cette religion sans être attiré par elle, et sans être convaincu par aucune d'entre elles."
Il a ensuite fait l'éloge de la moralité, de la tolérance et de la générosité des musulmans, et a souligné la capacité de l'islam à résoudre les problèmes d'inégalité sociale et de conflit de classes en déclarant : "L'islam est une source d'inspiration et d'inspiration pour tous :
"J'ai voyagé dans de nombreux pays à travers le monde, à l'est et à l'ouest, et j'ai eu l'occasion de voir comment l'étranger est reçu dans chaque endroit, et de savoir où l'honorer est la première chose qui vient à l'esprit, et que la première coutume est (de s'enquérir de lui et de l'intérêt ou du bénéfice qui peut découler de son aide)... Je n'ai pas trouvé de non-musulmans qui soient égaux à eux pour recevoir l'étranger, l'accueillir, l'honorer et lui montrer de la gentillesse sans attendre de retour ou sans attendre de bénéfice.... Sur le plan économique, nous constatons que seuls les groupes islamiques ont éliminé les différences entre les riches et les pauvres d'une manière qui ne pousse pas les pauvres à renverser la structure de la société et à attiser le chaos et les haines".
Contributions de l'orientaliste Hussein Ruf
L'orientaliste musulman anglais Hussein Ruf, l'un des plus éminents chercheurs sociaux européens à avoir étudié en profondeur les religions et les doctrines sociales, a été impressionné par la grandeur de l'islam, la noblesse de ses objectifs et de ses principes, sa capacité supérieure à résoudre les problèmes et à faire face aux troubles dont souffrent les individus et les sociétés humaines, ainsi que par sa merveilleuse adéquation à différents environnements et civilisations, quelles que soient leurs différences et leurs disparités.
Après l'islam, il était naturel pour lui de prendre l'initiative de prêcher cette religion, qui possédait son cœur, son esprit et ses sentiments, d'éclairer ses compatriotes sur ses principes de tolérance et ses nobles objectifs, tout en réfutant le flot de mensonges et en démolissant l'édifice d'illusions et de faussetés que les adversaires de l'islam y attachent.
Dieu est véridique lorsqu'Il dit : {Qui a un meilleur discours que celui qui appelle à Dieu, fait de bonnes actions et dit que je suis du nombre des musulmans} [Faslat : 33].
La source : Le livre du Dr Ragheb al-Sarjani (Grands hommes devenus musulmans).
Dr Hamid Markus Scientifique et journaliste allemand
L'histoire du Dr Hamed Markus, le scientifique allemand fasciné par le Coran Hamed Markus est un scientifique et journaliste allemand fasciné par le style du Coran. Scientifique et journaliste allemand
Dès mon enfance, j'ai ressenti le besoin d'étudier l'islam autant que possible, et j'ai pris soin de lire une version traduite du Coran dans la bibliothèque de la ville où j'ai grandi, édition dans laquelle Goethe a puisé ses informations sur l'islam.
J'ai été impressionné par la merveilleuse approche intellectuelle du Coran dans l'application des enseignements islamiques, et j'ai également été frappé par le grand esprit de persévérance que ces enseignements ont suscité dans le cœur des premiers musulmans.
À Berlin, j'ai eu l'occasion de travailler avec des musulmans et d'assister aux conférences enthousiastes et passionnantes du fondateur de la première association islamique de Berlin et du fondateur de la mosquée de Berlin sur le Saint Coran. Après des années de coopération pratique avec cette personnalité exceptionnelle, j'ai vu en lui son altruisme et son esprit, et j'ai cru en l'Islam, car j'ai vu dans ses nobles principes, qui sont considérés comme le sommet de l'histoire de la pensée humaine, ce qui complétait mes opinions personnelles.
La foi en Dieu est une doctrine fondamentale dans la religion de l'Islam, mais elle ne fait pas appel à des principes ou des doctrines incompatibles avec la science moderne, il n'y a donc pas de contradiction entre la foi d'une part et la science d'autre part, et c'est sans doute une caractéristique importante et unique aux yeux d'un homme qui a mis toute son énergie au service de la recherche scientifique.
La religion islamique n'est pas un enseignement théorique assourdissant qui court aveuglément en marge de la vie, mais elle appelle un système appliqué qui colore la vie humaine. Les lois de l'islam ne sont pas des enseignements obligatoires qui verrouillent les libertés individuelles, mais des directives et des orientations qui conduisent à une liberté individuelle organisée.
Au fil des années, j'ai été de plus en plus convaincu de l'évidence que l'islam est le meilleur moyen d'harmoniser la personnalité de l'individu et la personnalité du groupe, en les reliant par un lien fort et solide.
C'est une religion de droiture et de tolérance, qui ne cesse d'appeler à la bonté, de l'exhorter et de la promouvoir en toutes circonstances et en toutes occasions.
Source : Livre (Voyage de la foi avec des hommes et des femmes qui sont devenus musulmans) par : Abdul Rahman Mahmoud.
L'histoire des trois plus célèbres Britanniques convertis à l'islam à l'époque victorienne
Voici l'histoire de trois de ces pionniers qui ont défié les normes de l'ère victorienne, à une époque où le christianisme était la pierre angulaire de l'identité britannique, selon la BBC.
 William Henry Quilliam
William Henry Quilliam
Abdullah Quilliam
L'avocat William Henry Quilliam a commencé à s'intéresser à l'islam après avoir vu des Marocains prier sur un ferry lors d'une escale en Méditerranée en 1887.
Quilliam a déclaré : "Ils n'ont pas été dérangés par les vents violents ou le balancement du navire : "Ils n'ont pas été perturbés par les vents violents ni par le balancement du navire. J'ai été profondément ému en regardant leurs visages et leurs expressions, qui témoignaient d'une foi et d'une sincérité totales".“.
Après avoir recueilli des informations sur la religion pendant son séjour à Tanger, Quilliam, qui avait 31 ans à l'époque, s'est converti à l'islam et a décrit sa nouvelle foi comme étant "sensée et logique" et comme n'entrant pas en conflit, sur le plan personnel, avec ses croyances.“.
Bien que l'islam n'exige pas que les convertis changent de nom, Quilliam s'est choisi le nom d'"Abdullah".“.
Après son retour en Angleterre en 1887, il est devenu un propagandiste religieux, et l'on dit que grâce à ses efforts, quelque 600 personnes se sont converties à l'islam dans toute la Grande-Bretagne.
 En 1894, le sultan ottoman a conféré à Quilliam le titre de cheikh de l'islam dans les îles britanniques, avec l'approbation de la reine Victoria.
En 1894, le sultan ottoman a conféré à Quilliam le titre de cheikh de l'islam dans les îles britanniques, avec l'approbation de la reine Victoria.
La même année, Quilliam a également créé la première mosquée du pays à Liverpool, considérée par beaucoup à l'époque comme la "deuxième ville de l'Empire britannique".“.
La reine Victoria, dont le pays comptait plus de musulmans que l'Empire ottoman, a fait partie des personnes qui ont demandé une brochure rédigée par Quilliam, intitulée The Religion of Islam, dans laquelle il résume la religion musulmane. Cette brochure a été traduite en 13 langues..
Elle aurait commandé six exemplaires supplémentaires pour sa famille, mais son désir d'en savoir plus n'était pas du goût de l'ensemble de la communauté, qui pensait que l'islam était une religion de violence..
En 1894, le sultan ottoman a conféré à Quilliam le titre de "Sheikh of Islam in the British Isles", avec l'approbation de la reine Victoria, un titre qui reflétait son leadership au sein de la communauté musulmane.
De nombreux habitants de Liverpool qui se sont convertis à l'islam ont été victimes de ressentiment et de mauvais traitements en raison de leur foi. Ils ont notamment été attaqués à coups de briques, de déchets et d'engrais, malgré la reconnaissance officielle de cette religion..
Quilliam estime que les assaillants ont subi un "lavage de cerveau qui leur a fait croire que nous étions mauvais".“.
Connu localement pour son travail avec les groupes défavorisés, la défense des syndicats et la réforme de la loi sur le divorce, la carrière juridique de M. Quilliam a pris une mauvaise tournure lorsqu'il a cherché à aider un client qui voulait divorcer.
 Quilliam a participé à la construction de la deuxième plus ancienne mosquée de Grande-Bretagne à Woking.
Quilliam a participé à la construction de la deuxième plus ancienne mosquée de Grande-Bretagne à Woking.
Un piège a été tendu au mari qui aurait commis l'adultère, une pratique courante à l'époque, mais sa tentative a échoué et Quilliam a été suspendu de ses fonctions.
Il a quitté Liverpool en 1908 pour minimiser l'impact du scandale sur les musulmans de la ville, et est réapparu dans le sud sous le nom d'Henri de Leon, bien que de nombreuses personnes le connaissaient, selon Ron Davies, qui a écrit une biographie de Quilliam.
Bien que son influence ait diminué, il a participé à la construction de la deuxième plus ancienne mosquée du pays, construite à Woking, et a été enterré dans le Surrey en 1932.
La mosquée de Liverpool porte toujours son nom.
 Lady Evelyn
Lady Evelyn
Les mains d'Evelyn Cobbold
Il n'est pas surprenant qu'un membre de la classe supérieure ait été fasciné par l'islam et inspiré par les voyages en terre musulmane.
Issue d'une famille aristocratique d'Édimbourg, Lady Evelyn Murray a passé une grande partie de son enfance entre l'Écosse et l'Afrique du Nord.
Elle a écrit : "J'ai appris l'arabe là-bas : J'ai appris l'arabe là-bas, j'étais heureuse d'échapper à ma nounou et de visiter les mosquées avec des amis algériens, j'étais une musulmane involontaire dans l'âme".“.
Dans la propriété familiale de Dunmore Park, Evelyn chassait le cerf et pêchait le saumon..
Son père explorateur, le 7e comte de Dunmore, aimait voyager, notamment en Chine et au Canada. Sa mère, qui devint plus tard la dame d'honneur de la reine Victoria, était également une grande voyageuse.
 Lady Evelyn est la première femme britannique à accomplir le Hajj.
Lady Evelyn est la première femme britannique à accomplir le Hajj.
Lady Evelyn a hérité de ses parents le goût des voyages et a rencontré son mari, l'homme d'affaires John Cobbold, au Caire, en Égypte.
On ne sait pas quand Lady Evelyn s'est convertie à l'islam, la graine ayant peut-être été plantée lors des voyages de son enfance, mais la foi de Lady Evelyn semble s'être solidifiée après des vacances à Rome et une rencontre avec le pape..
Par la suite, elle a écrit : Lorsque Sa Sainteté s'est soudainement adressée à moi et m'a demandé si j'étais catholique, j'ai été surprise pendant un moment, puis j'ai répondu : "Je suis musulmane, et je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que je n'avais pas pensé à l'islam depuis des années". Le voyage a commencé et j'étais déterminé à lire et à étudier la religion“.
L'historien William Vasey, qui a rédigé la préface du Journal de Lady Evelyn, affirme que l'aspect spirituel de la religion a attiré de nombreux adeptes..
 Lady Evelyn, son mari John Cobbold et sa fille
Lady Evelyn, son mari John Cobbold et sa fille
Il a ajouté qu'ils suivaient "la croyance que toutes les grandes religions partagent une unité transcendante". Loin des détails doctrinaux superficiels qui les divisent“.
Les amis arabes de Lady Evelyn au Moyen-Orient l'appelaient "Lady Zainab", elle avait accès aux zones réservées aux femmes et écrivait sur "l'influence dominante des femmes" dans la culture islamique..
À l'âge de 65 ans, elle a effectué le Hajj et a été la première femme britannique à accomplir l'intégralité du pèlerinage..
Cela lui a valu "un intérêt et une admiration sans fin", et son histoire a ensuite été publiée dans un livre intitulé Pilgrimage to Mecca (Pèlerinage à la Mecque).“.
On sait peu de choses sur sa vie après son bref voyage au Kenya. Elle est décédée à la maison de retraite d'Inverness en 1963, à l'âge de 95 ans. Elle a demandé que l'on joue de la cornemuse lors de ses funérailles et qu'un verset du Coran, "Le signe de la lumière", soit inscrit sur sa pierre tombale..
Elle a écrit dans son journal : "Je me suis toujours demandé quand et pourquoi j'étais devenue musulmane“.
Elle a ajouté : "Ma réponse est que je ne connais pas le moment exact où la vérité de l'islam m'est apparue clairement.“.
"Il semble que j'ai toujours été musulman.“.
 Robert Stanley s'est converti à l'islam à l'âge de 70 ans
Robert Stanley s'est converti à l'islam à l'âge de 70 ans
Robert Stanley
Les récits de l'histoire des musulmans à l'époque victorienne sont généralement dominés par ceux qui appartenaient aux échelons supérieurs de la société, dont l'histoire est mieux préservée.
Mais Christina Longden, qui a découvert que son grand-père était musulman après que son père a fait des recherches sur l'arbre généalogique et conservé des documents écrits et un journal intime, a déclaré : "En général, il y a des signes qui montrent que c'est une affaire de classe moyenne : "En général, il y a des signes qui montrent que c'est une affaire de classe moyenne.“.
Robert Stanley est passé du statut d'épicier de la classe ouvrière à celui de maire conservateur de Stalybridge, une ville proche de Manchester, dans les années 1870.
Longden, qui a écrit un livre sur lui, affirme que Stanley était également juge et qu'il a créé un fonds pour les travailleurs licenciés parce qu'ils n'avaient pas voté avec leurs patrons.
J'ai également découvert qu'il écrivait régulièrement sur le colonialisme britannique dans le bulletin d'information de la mosquée Quilliam de Liverpool.
Il a rencontré Stanley Quilliam à la fin des années 1890, après qu'il se soit retiré de la vie politique, et tous deux ont noué une étroite amitié.
Longden explique : "Robert avait 28 ans de plus que Quilliam, je pense donc qu'il y avait une relation père-fils entre eux.“.
Il ne s'est toutefois converti à l'islam qu'à l'âge de 70 ans et a choisi le nom de "Rashid".“.
D'après ses recherches, Mme Longden pense qu'il n'y avait "aucun autre musulman" à Stourbridge à cette époque. Stanley s'est ensuite installé à Manchester, où il est décédé en 1911.
Sa conversion à l'islam a été tenue secrète jusqu'à ce qu'elle soit découverte par la famille Longden en 1998.
Par coïncidence, le frère de Longden, Stephen, s'est converti à l'islam en 1991 après avoir étudié en Égypte dans le cadre de son diplôme, sept ans avant que l'islam de grand-père Stanley ne soit découvert.
Lorsqu'il a appris la conversion de son grand-père, il l'a qualifiée de "surprise étonnante".“.
Le fait qu'un homme ait choisi d'être musulman à une époque où l'on n'imagine pas quelqu'un faire quelque chose d'aussi peu conventionnel, quand on y réfléchit, oui, c'est Manchester", a-t-il déclaré, ajoutant : "Les gens n'ont pas peur de se lever et de s'exprimer pour ce qu'ils croient, que ce soit sur le plan politique ou religieux : "Les gens n'ont pas peur de se lever et de parler de ce en quoi ils croient, que ce soit sur le plan politique ou religieux.“.
Malcolm X, l'homme qui est mort debout

Ce personnage important a eu le grand mérite - après Allah - de diffuser la religion islamique parmi les Noirs américains, à une époque où les Noirs américains souffraient gravement de la discrimination raciale entre eux et les Blancs, étaient soumis à des humiliations et subissaient les tourments de la torture et de la haine de la part de ces derniers
Dans ce climat turbulent d'oppression et d'humiliation, Malcolm X est né d'un père pasteur dans une église et d'une mère originaire des Antilles. Lorsqu'il avait six ans, son père a été tué par les Blancs qui lui ont fracassé la tête et l'ont placé sur la trajectoire d'un bus électrique qui l'a écrasé jusqu'à ce qu'il meure. La famille de Malcolm X a commencé à se détériorer rapidement. financièrement et émotionnellement. Ils vivaient de l'assistance et de l'aide sociale des Blancs, qu'ils étaient réticents à donner. Dans ces conditions difficiles, la mère de Malcolm X a souffert d'un traumatisme psychologique qui s'est développé jusqu'à ce qu'elle soit admise dans un hôpital psychiatrique où elle a passé le reste de sa vie. Malcolm X et ses huit sœurs ont souffert de l'amertume d'avoir perdu leur père et leur mère, et ils sont devenus des enfants pris en charge par l'État, qui les a répartis dans différents foyers...
Pendant ce temps, Malcolm X fréquente une école voisine où il est le seul élève noir. Comme il était intelligent et brillant et qu'il dépassait tous ses camarades, ses professeurs avaient peur de lui, ce qui les a amenés à le détruire psychologiquement et moralement, et à le ridiculiser, surtout lorsqu'il a voulu poursuivre ses études dans le domaine du droit... C'est le tournant de sa vie. Il abandonne l'école et passe d'un emploi dégradant à un autre, celui de nègre. De serveur dans un restaurant ouvrier dans les chemins de fer cireur de chaussures dans une discothèque. Jusqu'à ce qu'il devienne un danseur célèbre, puis qu'il soit tenté par une vie de frivolité et de perte et qu'il commence à boire de l'alcool et à fumer des cigarettes, et que le jeu devienne sa principale source d'économie. Il finit par consommer de la drogue et même en faire le trafic, puis par voler des maisons et des voitures. Tout cela alors qu'il n'avait pas encore vingt et un ans. Jusqu'à ce que lui et ses copains se fassent attraper par la police. Ils l'ont condamné à une peine exagérée de dix ans de prison, alors que pour les Blancs, la peine de prison ne dépassait pas cinq ans.
En prison, Malcolm X s'est abstenu de fumer ou de manger du porc, et il a dévoré des milliers de livres dans divers domaines de la connaissance, établissant une haute culture qui lui a permis de combler les lacunes de sa personnalité.
À cette époque, tous les frères de Malcolm X ont été convertis à l'islam par un homme appelé M. Mohammed Elijah. Tous les frères de Malcolm X ont été convertis à l'islam par un homme appelé M. Mohammed Elijah, qui prétendait être un prophète de Dieu envoyé uniquement aux Noirs. Ils ont tenté de persuader Malcolm X de se convertir à l'islam par divers moyens jusqu'à ce qu'il devienne musulman. Sa moralité et son caractère se sont améliorés et il a commencé à participer à des discours et à des débats à l'intérieur de la prison pour prêcher l'islam. Jusqu'à ce qu'il soit gracié et libéré afin qu'il ne continue pas à prêcher l'islam en prison
Malcolm X était affilié au mouvement Nation of Islam, qui avait des idées fausses et des fondements racistes incompatibles avec l'islam, même s'il utilisait l'islam comme un slogan brillant. Ils étaient intolérants à l'égard de la race noire et faisaient de l'Islam une exclusivité pour eux et non pour les autres races, alors qu'ils possédaient la morale vertueuse et les valeurs élevées de l'Islam... En d'autres termes, ils ont pris à l'Islam son apparence et lui ont laissé son essence et son expérience.
Malcolm X a continué dans les rangs de la Nation de l'Islam, invitant les gens à la rejoindre par ses discours éloquents et sa forte personnalité. Il a été un soutien infatigable et un bras inlassable de force, de vigueur et d'agressivité... jusqu'à ce qu'il soit capable d'attirer de nombreuses personnes à rejoindre ce mouvement.
Malcolm X souhaitait accomplir le Hajj et, lors de son voyage, il a vu de près le véritable islam et s'est rendu compte de l'erreur de la doctrine raciste qu'il épousait et défendait. Il a embrassé la véritable religion islamique et s'est appelé Hajj Malik Shabazz.
À son retour, il s'est consacré à la prédication du véritable islam et a tenté de corriger les concepts erronés de la Nation de l'islam. Cependant, il s'est heurté à l'hostilité et à la haine de ces derniers, qui ont commencé à le harceler et à le menacer, mais il ne s'en est pas soucié et a continué à marcher d'un pas clair et ferme en appelant à un véritable islam qui élimine toutes les formes de racisme.
Lors d'un de ses éloquents sermons prêchant l'appel à Dieu, les tyrans refusèrent de faire taire la voix de la vérité. Ils l'ont assassiné alors qu'il se tenait sur l'estrade pour prêcher au peuple : seize balles perfides ont été tirées sur son corps long et mince. Et ce fut la fin. Nous prions pour qu'Allah l'accueille dans sa dernière demeure. Nous demandons à Dieu de l'accepter parmi les martyrs le jour du Jugement dernier.
.
Muhammad Ali Clay
 Muhammad Ali Clay, né Cassius Marcellus Marcellus Clay Jr. le 17 janvier 1942, est un ancien boxeur professionnel américain, considéré comme une icône culturelle et un personnage aimé de tous, malgré les critiques dont il a fait l'objet.
Muhammad Ali Clay, né Cassius Marcellus Marcellus Clay Jr. le 17 janvier 1942, est un ancien boxeur professionnel américain, considéré comme une icône culturelle et un personnage aimé de tous, malgré les critiques dont il a fait l'objet.
Son Islam
Il a changé son nom de "Cassius" en "Muhammad Ali", mais sans le surnom "Clay", qui signifie boue en anglais, après s'être converti à l'islam en 1964. Il ne s'est pas soucié de ce qui pourrait nuire à sa popularité, qui s'est accrue et l'amour des gens pour lui a balayé les horizons, et la religion islamique a été une raison importante de son succès : La religion islamique interdit les guerres qui ne sont pas menées pour le bien d'Allah et de son messager et pour hisser la bannière de l'islam, comme il l'a déclaré : "Je ne les combattrai pas [...] parce qu'ils ne m'ont pas traité de nègre [...]".Il ne s'est pas soucié de la baisse de sa popularité auprès des Américains à la suite de cette déclaration et a été arrêté et condamné pour évasion, déchu de son titre de boxeur, sa licence a été suspendue et il n'a pas combattu pendant quatre ans, après avoir fait appel de sa condamnation devant la Cour suprême des États-Unis d'Amérique et avoir finalement obtenu gain de cause pour remonter sur le ring de boxe.
Boxe
Il a ensuite remporté trois fois le titre de champion du monde des poids lourds et Ali a participé à plusieurs combats historiques, dont les plus marquants sont peut-être les trois combats suivants : le premier contre le concurrent le plus fort, Joe Frazier, et le second contre George Foreman, au cours duquel il a récupéré son titre qui lui avait été retiré pendant sept ans et Ali s'est caractérisé par son style de combat non conventionnel Ali se distinguait par son style de combat non conventionnel, esquivant comme un papillon, attaquant comme une abeille, habile et courageux pour résister aux coups jusqu'à ce qu'il devienne le plus célèbre du monde, car il est le détenteur du coup de poing le plus rapide du monde, qui a atteint une vitesse de 900 kilomètres à l'heure, et il était également connu pour son discours avant ses matchs, car il s'appuyait fortement sur les déclarations des médias.
Sa maladie
Muhammad Ali a été atteint de la maladie de Parkinson, mais il reste à ce jour une icône sportive bien-aimée. Pendant sa maladie, il a été extrêmement patient, car il a toujours dit que Dieu l'avait affligé pour lui dire qu'il n'était pas le plus grand, mais que c'était Dieu qui était le plus grand.
Honoré
À Hollywood, il existe une rue très célèbre appelée "Celebrity Street", où l'on peint une étoile au nom de toutes les célébrités.
Lorsqu'ils ont proposé au boxeur musulman Muhammad Ali Clay de faire peindre une étoile à son nom dans la rue, il a refusé, et lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi il refusait que son nom soit immortalisé dans la rue par une étoile ?
Il leur a dit : "Je porte le nom du prophète auquel je crois, Muhammad (que la paix soit avec lui), et je refuse catégoriquement de dessiner le nom "Muhammad" sur le sol".
Mais en l'honneur de sa popularité et du succès qu'il a rencontré tout au long de sa carrière, Hollywood a décidé de peindre l'étoile "Muhammad Ali" sur un mur de la rue et non sur le sol comme d'autres célébrités.
À ce jour, il n'y a pas d'autre célébrité dont le nom figure sur le mur que Muhammad Ali. Les autres célébrités ont leur nom sur le sol.
Ses actions caritatives
En 2005, Muhammad Ali Clay a créé un centre dans sa ville natale de Louisville, le Muhammad Ali Centre, où il expose actuellement des souvenirs et travaille en tant qu'organisation à but non lucratif pour diffuser les idées de paix, de prospérité sociale, d'aide aux personnes dans le besoin et les nobles valeurs auxquelles croyait Muhammad Ali Clay.
Abdullah Al-Tarjman
 Abdullah al-Mayurki, ou Abdullah al-Mayurki, connu sous le nom d'Abdullah al-Tarjaman, était un chrétien espagnol de l'île de Majorque et un prêtre très respecté. Il était également l'un des plus grands érudits chrétiens du huitième siècle de l'ère chrétienne, et son nom avant sa conversion était Anselm Tormida, mais lorsque Dieu lui a expliqué l'islam, il s'est appelé al-Tarjaman Il a écrit le livre "Tahfat al-Areeb en réponse aux gens de la croix" en arabe en 823 de l'Hégire, puis traduit en français et publié dans le Journal de l'histoire des religions à Paris en 1885.
Abdullah al-Mayurki, ou Abdullah al-Mayurki, connu sous le nom d'Abdullah al-Tarjaman, était un chrétien espagnol de l'île de Majorque et un prêtre très respecté. Il était également l'un des plus grands érudits chrétiens du huitième siècle de l'ère chrétienne, et son nom avant sa conversion était Anselm Tormida, mais lorsque Dieu lui a expliqué l'islam, il s'est appelé al-Tarjaman Il a écrit le livre "Tahfat al-Areeb en réponse aux gens de la croix" en arabe en 823 de l'Hégire, puis traduit en français et publié dans le Journal de l'histoire des religions à Paris en 1885.
L'histoire de l'islam d'Abdullah Al-Tarjman
Abdullah al-Tarjuman a raconté l'histoire de son islam dans son livre Tahfat al-Areeb : À l'âge de six ans, j'ai été confié à un prêtre enseignant et j'ai lu la Bible jusqu'à ce que j'en mémorise plus de la moitié en deux ans, puis j'ai commencé à apprendre la langue de la Bible et la science de la logique Ensuite, j'ai voyagé de Majorque à la ville de Llarda, en Catalogne, qui est la ville du savoir parmi les chrétiens de ce pays, et c'est dans cette ville que se réunissent les chrétiens qui étudient le savoir ; j'ai donc lu les sciences naturelles et les étoiles pendant six ans, puis j'ai lu la Bible et je l'ai enseignée pendant quatre ans.
Puis je me suis rendu dans la ville de Baluniya et j'y ai vécu, qui est une ville de savoir et qui possède une église pour un prêtre d'un grand âge et d'un grand destin nommé Naghlomartil, et son statut dans la science, la religion et l'ascétisme était très élevé, de sorte que des questions sur la religion du christianisme et des cadeaux lui sont parvenus de la part de rois et d'autres, et ils ont même voulu être bénis par lui et accepter leurs cadeaux et en ont été honorés, alors j'ai lu les bases de la religion du christianisme et ses règles à ce prêtre et je me suis rapproché en le servant et en faisant beaucoup de ses travaux jusqu'à ce qu'il fasse de moi l'un de ses meilleurs spécialistes et me paye les clés de sa résidence et les coffres de sa nourriture et de sa boisson. Je suis resté avec lui en lisant et en le servant pendant dix ans, puis un jour il est tombé malade et n'a pas pu assister à son conseil de lecture et les gens du conseil l'ont attendu en discutant de sujets de connaissance jusqu'à ce qu'ils arrivent à la parole de Jésus, paix sur lui : " Un prophète viendra après moi dont le nom est Baraklit " Ils ont discuté de la nomination de ce prophète et de qui il est parmi les prophètes et chacun d'eux a dit selon sa connaissance et sa compréhension, ils ont donc eu une grande discussion et se sont ensuite quittés sans avoir gagné aucun bénéfice dans cette affaire.
Je lui ai parlé de la différence entre les gens sur le nom du Paraclet et j'ai dit qu'untel avait répondu de telle façon et untel de telle autre, et j'ai énuméré leurs réponses. Il m'a dit : " Qu'avez-vous répondu ? " J'ai dit : " La réponse du juge untel dans l'interprétation de l'Évangile ". Il m'a dit : " Vous êtes proches et proches, et untel s'est trompé, et untel a failli être proche, mais la vérité est à l'opposé de tout cela, parce que l'interprétation de ce nom honoré ne peut être connue que par des savants qui sont bien établis dans la connaissance, et vous avez peu de connaissance de la connaissance que vous avez atteinte ".
Je me suis précipité à ses pieds, je les ai embrassés et je lui ai dit : "Monsieur, vous savez que j'ai voyagé jusqu'à vous depuis un pays lointain : "Monsieur, vous savez que j'ai voyagé jusqu'à vous depuis un pays lointain et que j'ai été à votre service pendant dix ans, au cours desquels j'ai obtenu de vous un nombre de sciences que je ne peux pas compter, alors peut-être que ce serait une grande faveur pour vous de m'accorder la connaissance de ce noble nom. Le cheikh pleura et dit : "Mon fils, par Dieu, tu m'es très cher pour ton service et ta dévotion envers moi, et la connaissance de ce saint nom est d'un grand bénéfice, mais je crains que si tu le montres, les chrétiens te tueront immédiatement. Il dit : "Ô mon seigneur, tu sais que j'ai voyagé jusqu'à toi depuis un pays lointain.
Je lui dis alors : "Par Allah, par la vérité de l'Evangile et de ceux qui l'ont accompagné, je ne dirai rien de ce que tu me diras, si ce n'est sur ton ordre. Il me dit : "Mon fils, lorsque tu es venu me voir pour la première fois, je t'ai interrogé sur ton pays et je t'ai demandé s'il était proche des musulmans et s'ils t'approuvaient ou si tu les approuvais, afin de tester ton aversion pour l'islam. Sache, mon fils, que le Baraklit est l'un des noms de leur prophète Muhammad, et que c'est sur lui qu'a été révélé le quatrième livre mentionné dans la langue de Daniel, que la paix soit sur lui, et qu'il a dit que ce livre lui serait révélé et que sa religion est la religion de la vérité et que son école est l'école blanche mentionnée dans l'Injil.
Il m'a dit : "Mon fils, si les chrétiens étaient restés dans la religion du premier Jésus, ils auraient été dans la religion de Dieu, parce que Jésus et tous les prophètes sont dans la religion de Dieu. J'ai dit : "Monsieur, comment puis-je sortir de cette affaire ?" Il a répondu : "Mon fils, en entrant dans la religion de l'Islam. Je lui ai dit : "Celui qui entre dans cette religion survit-il ?" Il a répondu : "Oui, il survivra dans ce monde et dans l'au-delà.
Je lui ai dit : "Mon seigneur, un homme sage ne choisit pour lui-même que le meilleur de ce qu'il connaît : "Mon seigneur, un homme sage ne choisit pour lui-même que le meilleur de ce qu'il connaît, alors si tu connais les vertus de la religion de l'Islam, qu'est-ce qui t'en empêche ? " Il me répondit : Mon fils, Allah ne m'a révélé la vérité de ce que je t'ai dit sur la vertu et l'honneur de la religion de l'Islam qu'après ma vieillesse et l'affaiblissement de mes os, et il n'y a pas d'excuse pour nous, mais l'argument d'Allah contre nous tient, et si Allah m'avait guidé vers cela alors que j'étais à ton âge, j'aurais tout abandonné et je serais entré dans la vérité, et l'amour du monde est la tête de tout péché, et tu vois ce que je suis parmi les chrétiens de haut prestige, de destin, de gloire, d'honneur et de nombreuses offres mondaines, et si j'ai montré un penchant pour la religion de l'Islam, le public m'aurait tué plus tôt que plus tard.
Si je leur échappais, que je parvienne aux musulmans et que je leur dise que je suis venu à vous en tant que musulman, ils me diraient : "Tu t'es enrichi en entrant dans la religion de la vérité, alors ne nous accorde pas une religion dans laquelle tu t'es sauvé du châtiment de Dieu" ; je resterais parmi eux comme un pauvre vieillard de quatre-vingt-dix ans, ne connaissant ni leur langue ni mon droit, et je mourrais de faim au milieu d'eux.
Je suis, grâce à Dieu, de la religion de Jésus et de ce qu'il a apporté, et Dieu sait cela de moi. Je lui ai donc dit : "Monsieur, me donnez-vous la permission d'aller dans le pays des musulmans et d'entrer dans leur religion ? "Il m'a répondu : "Si tu es sain d'esprit et que tu veux survivre, tu devrais le faire, afin d'avoir le monde et l'au-delà, mais mon fils, il s'agit de quelque chose que personne n'est présent avec nous en ce moment, alors garde-le secret du mieux que tu peux, et si l'une de ces choses t'apparaissait, le public te tuerait pour ton temps, et je ne peux pas t'aider, et cela ne te servira à rien de me le rapporter, parce que je le nie et que ma déclaration est crue par toi et la tienne n'est pas crue par moi, et je suis innocent de ton sang si tu perds quoi que ce soit.
J'ai alors pris les raisons du voyage et lui ai fait mes adieux. Il a bien prié pour moi et m'a donné cinquante dinars d'or. J'ai embarqué sur la mer, en partance pour le pays de Majorque, où je suis resté six mois, puis j'ai voyagé de là jusqu'à la ville de Sicile, où je suis resté cinq mois, en attendant un bateau pour aller au pays des musulmans. Un bateau allant à Tunis est arrivé, et j'ai donc voyagé depuis la Sicile avec lui.
Je suis resté avec eux dans leur hospitalité pendant quatre mois, après quoi je leur ai demandé s'il y avait quelqu'un dans la maison du sultanat qui connaissait la langue des chrétiens, et le sultan de l'époque était Mawlana Abu al-Abbas Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, et les chrétiens m'en ont parlé : J'en ai été très heureux et j'ai demandé la résidence de ce médecin, qui m'a été indiquée. Je l'ai rencontré et je lui ai expliqué ma situation et la raison de mon adhésion à l'islam, et il a été très heureux que cette bonne action soit accomplie par ses mains.
Il monta à cheval et me conduisit avec lui à la maison du sultan. Il entra, lui raconta ma conversation et lui demanda la permission de me faire comparaître devant lui. La première chose qu'il me demanda fut mon âge, et je lui répondis que j'avais trente-cinq ans, puis il me demanda ce que j'avais lu dans les sciences : J'ai dit à l'interprète, qui est le docteur mentionné : "Dites à notre sultan qu'il ne sorte pas : Dites à notre sultan que personne ne sort de sa religion sans que son peuple ne le dise et ne le calomnie, alors je voudrais que vous envoyiez les marchands chrétiens et les bonnes gens en votre présence et que vous les interrogiez à mon sujet et que vous écoutiez ce qu'ils disent de moi, et alors je deviendrai musulman, si Dieu le veut, alors il m'a dit par l'intermédiaire de l'interprète : Vous avez demandé comme Abdullah Ibn Salam a demandé : Tu as demandé comme Abdullah Ibn Salam a demandé au Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) et il est devenu musulman.
Il envoya chercher les meilleurs chrétiens et quelques-uns de leurs marchands et m'installa dans une maison proche de son conseil, et lorsque les chrétiens entrèrent, il leur dit : "Que dites-vous de ce nouveau prêtre qui est arrivé dans ce bateau ? "Ils répondirent : "O notre seigneur, c'est un grand savant dans notre religion, et nous n'avons jamais vu un plus haut degré de savoir et de religion que lui." Il dit : "Que direz-vous de lui s'il devient musulman ?" Ils répondirent : "Nous interdisons cela à Dieu, il ne fera jamais cela." Quand il entendit ce que les chrétiens avaient à dire, il m'envoya chercher, et je me présentai devant lui et témoignai de la vérité en présence des chrétiens, et ils tombèrent sur leur visage et dirent : "Il ne lui a fait faire cela que pour l'amour du mariage, parce que nos prêtres ne se marient pas.
Lorsque j'ai décidé de me marier, il m'a donné cent dinars d'or et un bon costume complet. J'ai donc pris femme et un fils m'est né, que j'ai appelé Muhammad en l'honneur de notre prophète Muhammad, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix[1].
Fatima Herin
Le véritable sens de l'islam est que les croyants s'en remettent entièrement à Allah, le Tout-Puissant, dans leur propre personne et dans leurs petites et grandes affaires.
Ils doivent s'en remettre à la main qui les guide, confiants qu'elle leur veut du bien, qu'elle les conseille et les guide, et qu'elle leur assure le chemin et le destin dans ce monde et dans l'au-delà ; conformément aux paroles de Dieu Tout-Puissant : {Dis que ma prière, mes rites, ma vie et ma mort sont pour Dieu, le Seigneur des mondes * Il n'y a pas d'associé pour Lui, et c'est ainsi que j'ai ordonné, et je suis le premier des Musulmans} [Al-Anam : 162, 163].
C'est la question qui préoccupait Fatima Heeren, une Allemande qui s'est convertie à l'islam après avoir grandi dans le national-socialisme, dans lequel le rôle de Dieu est absent de toutes les affaires de la création ou de leur vie quotidienne.
Slogans nationalistes
Fatima Herrin est née en Allemagne en 1934 d'un père qui travaillait dans l'armée allemande et chérissait les valeurs national-socialistes.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est achevée en 1945, Fatima était une élève de onze ans. Les rêves de la nation allemande ont été brisés et tous les idéaux pour lesquels des vies avaient été sacrifiées ont été anéantis.
Dans les années qui ont précédé la guerre et pendant celle-ci, le nationalisme a été un excellent moyen de pousser les Allemands à bout, avec pour seul souci de tout faire pour la patrie.
Ce nationalisme a eu un impact sur l'idée de l'existence de Dieu : pour la société allemande, Dieu est la puissance qui a établi les lois de la nature il y a des millions d'années, et ces lois ont à leur tour créé les êtres humains, très probablement par hasard.
Fatima Hirin évoque l'état d'esprit de sa communauté à l'époque : Le christianisme était la seule foi qui nous confrontait vraiment, et on nous la présentait comme "l'opium des peuples", la foi des moutons qui ne se déplacent que par peur de la mort.
Nous avons compris que chaque personne est responsable d'elle-même et libre de faire ce qu'elle veut tant que cela ne nuit pas à autrui, et nous avons imaginé que la conscience est la seule lumière qui nous guide.
Beaucoup de gens comme moi étaient mécontents du fonctionnement de la société moderne, mais ils prétendaient toujours être heureux, et lorsqu'ils se réveillaient après une nuit de danse et d'alcool, ils ressentaient un vide dans leur poitrine qui ne pouvait être comblé par davantage de danse, d'alcool ou de flirt au cours des soirées suivantes".
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Fatima a déclaré : "Non seulement la guerre a déchiré notre pays (l'Allemagne), mais la grandeur de notre nation a été brisée : "Non seulement la guerre a déchiré notre pays (l'Allemagne), mais la grandeur de notre nation a été brisée et tous les idéaux pour lesquels des vies ont été perdues.
J'ai réalisé que la conscience individuelle et les idéaux humanitaires acceptés par la société ne suffisaient pas à guider ma vie. Je ne me sentais pas vraiment heureux de profiter de la félicité qui m'était offerte sans remercier qui que ce soit pour toutes les bontés qui m'étaient accordées. J'ai tenu un journal quotidien, et une fois je me suis surpris à noter la déclaration suivante : "Ce fut une journée joyeuse ; merci beaucoup, ô Seigneur !
Au début, j'ai eu honte, puis j'ai compris qu'il ne me suffisait pas de croire en un Dieu... Je savais qu'il était de mon devoir de le rechercher, de chercher un moyen de le remercier et de l'adorer."
L'invalidité du christianisme
Après l'échec du projet nationaliste de son pays en termes de culture et de foi, Fatima Herin s'est tournée vers le christianisme pour trouver le chemin de Dieu : Un prêtre m'a conseillé de me convertir au christianisme et d'aller à la Cène. Il m'a dit : "Parce qu'en pratiquant la religion chrétienne, tu trouveras sûrement un chemin vers Dieu". J'ai suivi son conseil, mais je n'ai pas tenu la promesse de la Cène. J'ai suivi son conseil, mais je n'ai pas réussi à atteindre la véritable paix de l'esprit."
Fatima Hirin a expliqué la raison de sa déception à l'égard du christianisme : "Nous, chrétiens, devons accepter des compromis dans notre foi pour vivre dans notre société ; l'Église est toujours prête à faire des compromis pour maintenir son pouvoir dans notre société, pour donner un exemple : L'Église dit : Les relations sexuelles ne doivent commencer qu'après le mariage au nom de Dieu, mais presque aucun homme ou femme en Occident "n'achète le chat dans le sac", ce qui est un proverbe commun qui signifie que l'on entre dans le mariage sans avoir d'abord testé la compatibilité sexuelle des deux partenaires l'un avec l'autre.
Le prêtre est toujours prêt à absoudre toute personne qui confesse ce péché par une ou deux prières".
Contrairement à ce qui précède, l'islam appelle ses adeptes, au nom de la foi, à remettre tout leur être à Allah, le Tout-Puissant, sans hésiter et sans se détourner ; une remise après laquelle il ne restera aucun vestige rebelle de perception ou de sentiment, d'intention ou d'action, de désir ou de crainte qui ne se soumette pas à Allah et n'accepte pas Sa règle et Son jugement ; comme le dit le Tout-Puissant {Ô vous qui croyez, entrez en paix tous ensemble et ne suivez pas les traces de Satan, car il est un ennemi évident pour vous [Al-Baqarah : 208].
Fatima Hirin et le chemin vers l'islam
Fatima Hirin cherchait un principe parfait auquel s'accrocher, un chemin droit sur lequel placer toute sa vie, si bien qu'elle n'arrivait pas à s'approcher de Dieu, même lorsqu'elle s'agenouillait à l'église.
En 1957, Fatima Herren rencontre pour la première fois celui qui deviendra son mari deux ans plus tard, un musulman allemand titulaire d'un doctorat en philosophie.
Mais lorsqu'il m'a dit qu'il s'était converti à l'islam il y a sept ans, j'ai été tellement surpris que j'ai voulu savoir pourquoi un homme aussi instruit que lui avait choisi cette voie.
Mon mari m'a expliqué la signification de l'islam : Allah n'est pas seulement le Seigneur des musulmans, mais ce mot "Allah" est synonyme de "divinité" pour nous, et que les musulmans croient en l'unicité absolue du Créateur, et qu'ils n'adorent pas leur prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, comme les chrétiens adorent Jésus-Christ, et que le mot "Islam" signifie la soumission totale au seul et unique Dieu.
Il m'a dit que tous les êtres et toutes les choses sont nécessairement considérés comme acquis du point de vue islamique, c'est-à-dire qu'ils doivent se soumettre et se rendre aux lois de Dieu, et s'ils ne le font pas, ils sont menacés d'anéantissement.
Il a ajouté : L'être humain seul - que son corps soit musulman volontairement ou involontairement - est doté par Dieu de la liberté de volonté et de choix pour décider s'il veut être musulman dans sa vie spirituelle et physique. S'il le fait et vit selon cette décision, alors il se connectera à Dieu et trouvera l'harmonie et la paix psychologique avec les autres créatures dans cette vie terrestre, et trouvera le bonheur dans l'au-delà.
Mais s'il se rebelle contre les lois de Dieu, qui nous sont clairement et magnifiquement révélées dans le Saint Coran, il est perdant dans cette vie et dans l'autre".
Fatima ajoute ce qu'elle a découvert sur l'islam : "J'ai également appris de mon mari que l'islam n'est pas une nouvelle religion ; en fait, le Coran est le seul livre exempt de toute déviation ou imperfection, et c'est le dernier livre céleste d'une longue série de livres, notamment les révélations de la Torah et de l'Évangile.
Sur les conseils de mon mari, j'ai commencé à lire les quelques livres disponibles sur l'islam en allemand, à savoir les quelques livres disponibles du point de vue islamique, dont le plus important était Le chemin de la Mecque de Muhammad Asad, qui a été une grande source d'inspiration pour moi.
Quelques mois après notre mariage, j'ai appris à prier en arabe, à jeûner et à étudier le Coran, avant de me convertir à l'islam en 1960.
La sagesse du Coran remplissait mon âme d'amour et d'admiration, mais la prunelle de mes yeux était la prière ; je sentais fortement que Dieu était avec moi alors que je me tenais humblement entre ses mains en récitant le Coran et en priant".
L'islam comme mode de vie
Fatima Hirin a refusé que la religion reste un coin limité de sa vie comme c'était le cas auparavant, ou peut-être même qu'elle n'en soit pas un du tout.
Fatima a décidé de vivre toute sa vie selon l'islam et d'en faire une approche complète de sa vie, même si cela signifiait qu'elle devait émigrer.
Fatima Hirin a déclaré : "J'ai commencé à observer régulièrement les cinq prières quotidiennes : "J'ai commencé à observer régulièrement les cinq prières quotidiennes et j'ai appris que la prière n'est pas quelque chose que l'on accomplit au fur et à mesure, mais qu'il s'agit en fait d'un système dans lequel toute la journée doit être modelée.
J'ai appris à me contenter de la situation dans laquelle mon mari est assis avec ses frères en religion, discutant avec eux pendant que je prépare le thé et le sers à la porte, sans savoir pour qui je l'ai préparé, et au lieu d'aller au marché, j'avais l'habitude de rester à la maison pour lire des livres islamiques en anglais.
J'ai également commencé à jeûner et j'avais l'habitude de préparer des repas sans les goûter, malgré l'intensité de la faim et de la soif à certains moments.
J'ai appris à aimer notre prophète Muhammad et ses compagnons en lisant les livres de hadiths du prophète ; ils sont devenus pour moi des figures humaines vivantes, et pas seulement des modèles historiques étonnants.
Les exemples de gentillesse, de courage, de dévouement et de bonté donnés par ces premiers êtres humains sont devenus des étoiles qui m'ont guidé, et j'ai compris comment façonner ma vie de manière à être une personne bonne et satisfaite dans cette vie, un chemin dont le comportement détermine le type de récompense que nous recevrons dans la suivante".
Dans son effort pour vivre selon l'islam et l'appliquer dans tous les aspects de sa vie, Fatima Hirin a déclaré : "Mon mari et moi avons convenu que notre vie islamique dans un pays occidental nous obligerait à faire de nombreux compromis : "Mon mari et moi avons convenu que notre vie islamique dans un pays occidental nous obligerait à faire de nombreux compromis. L'islam n'est pas seulement une religion au sens commun du terme, mais un mode de vie complet qui ne peut être appliqué dans sa forme la plus pure que dans une société musulmane. Comme nous avons tous deux choisi cette religion de plein gré, nous ne voulions pas d'un islam tiède et faible.
Après une longue attente, en 1962, nous avons eu la possibilité d'émigrer au Pakistan après avoir économisé suffisamment d'argent pour couvrir les frais du voyage.
Fatima Hirin et la défense de l'islam
Fatima a défendu l'islam et démontré la grandeur et la pureté de la loi islamique, tout en dénonçant la fausseté et l'égarement des autres religions : "Si ceux qui ont des préjugés contre l'islam disent qu'il est barbare pour un homme de prendre plusieurs femmes pour lui, peuvent-ils me montrer le bien inhérent à leur comportement lorsqu'un mari prend des petites amies en plus de sa femme ? Cette pratique est plus courante en Occident que la polygamie dans les pays musulmans.
S'ils affirment que leur consommation d'alcool n'est pas nocive, peuvent-ils expliquer pourquoi cette habitude est à l'origine de tant de malheurs en Occident ?
S'ils disent que le jeûne affaiblit la main-d'œuvre et les conditions sanitaires de la nation, qu'ils jettent un coup d'œil sur les grandes réalisations accomplies par les croyants pendant le mois béni du ramadan et qu'ils lisent les rapports importants récemment enregistrés par des médecins musulmans sur leurs expériences naturelles avec des patients qui jeûnent.
S'ils disent que la séparation des sexes est trop tardive, qu'ils comparent la jeunesse de n'importe quel pays musulman à celle de n'importe quel pays occidental, car le délit moral entre un garçon et une fille est considéré comme une exception chez les musulmans, tandis que chez les Occidentaux, il est très rare de trouver un seul mariage entre un garçon chaste et une fille chaste.
Si ceux qui ont des préjugés contre l'Islam prétendent que l'observation de cinq prières chaque jour et chaque nuit - dans une langue inconnue de nombreux croyants - est une perte de temps et une dépense inutile d'efforts, qu'ils nous montrent un système en Occident qui unit les gens d'une manière plus forte et plus sûre pour le corps et l'esprit que les rituels dévotionnels musulmans. Qu'ils nous prouvent que les Occidentaux accomplissent un travail plus utile pendant leur temps libre qu'un musulman qui consacre une heure par jour à la prière.
L'Islam a été valable pendant quatorze siècles ou plus, et le reste à notre époque, à condition que nous le portions sans compromis déformés.
De nos jours, de nombreuses personnes ont pris conscience de ce fait et, si Dieu le veut, elles coopéreront pour le montrer au monde malade, tourmenté et misérable qui les regarde".
C'est ainsi que Fatima Hirin a changé après s'être convertie à l'islam. Elle croyait que l'islam n'était pas seulement une question de rituels et d'adoration, mais qu'il s'agissait d'une vie et d'une approche complètes qui permettraient à un musulman de vivre heureux dans ce monde et le conduiraient au paradis dans l'au-delà.
Contributions de Fatima Hirin
Elle a écrit plusieurs livres sur l'islam, notamment : (Fasting - Das Fasten) 1982, (Zakat - Zakat) 1978, et (Muhammad - Muhammad) 1983.
La source : Le livre du Dr Ragheb al-Sarjani (Grands hommes devenus musulmans).
Luis Garde
Louis Gardi est considéré comme l'un des philosophes européens les plus éminents à avoir étudié en profondeur la pensée et la civilisation islamiques. Dès son plus jeune âge, Louis Gardi s'est passionné pour l'étude des principes des religions révélées. Bien qu'il ait grandi dans une famille catholique conservatrice, il était hanté par une obsession psychologique pour les mystères et les secrets qu'il voyait dans sa propre religion, ce qui l'a conduit à rechercher les origines des religions orientales telles que le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres, afin d'atteindre la vérité.
L'histoire de l'islam de Louis Garde
Louis Gardet a lu une traduction du sens du Coran et y a trouvé beaucoup de choses qui ont rassuré son cœur, il a donc été attiré par l'Islam et a commencé lentement à approfondir l'Islam, à apprendre l'arabe, à lire le Coran en arabe, puis à se tourner vers l'étude de la civilisation islamique et a découvert que l'Islam était sa destination souhaitée et qu'il y croyait en tant que véritable doctrine divine (dans son cœur). Il croyait en l'islam comme une véritable foi divine (avec son cœur). Parce qu'il était sûr que ceux qui avaient embrassé l'islam et l'avaient popularisé en Europe avaient rencontré de nombreux obstacles, Garde cacha sa foi dans son cœur et limita ses efforts, son travail, son argent et sa pensée à la victoire de cette religion.
Louis Garde a noté que le sionisme mène une guerre d'agression contre tout ce qui est islamique en Europe, dans laquelle tous les moyens agressifs ont été utilisés, à commencer par les tentatives de déformation de certains versets du Saint Coran, l'exportation du Saint Coran vers de nombreuses régions africaines après l'avoir déformé, la conception de sous-vêtements et de chaussures avec des inscriptions et des symboles islamiques qui sont sacrés et respectés dans la conscience de chaque musulman, et la contribution à l'encouragement de chercheurs fanatiques à publier leurs livres et études qui déforment l'image de l'Islam et attribuent des vices et des vices aux musulmans et à leur Prophète.
Contributions de Louis Garde
Louis Gardet a défendu l'islam et publié le livre "Les musulmans face aux attaques sionistes". Il s'est également consacré à l'étude de la philosophie islamique pendant quinze ans (1957-1972) à l'Institut international de philosophie de Toulouse.
Il est également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages islamiques importants, tels que : La société islamique, L'islam pour tous les âges et Religion et société. Il supervise la publication d'une série d'études islamiques et participe à l'élaboration d'une encyclopédie islamique en langue française.
Dans ce livre, il explique comment les valeurs et les principes islamiques ont traversé les âges et les générations, et restent frais, renouvelables, recherchés et influents à chaque époque.
Dans ce livre, Jardet rejette l'affirmation de certains théoriciens philosophiques selon laquelle l'islam est une religion du désert et ne convient pas à d'autres sociétés ; il répond à ces matérialistes en disant : "Le désert n'a été que le lieu et le point de départ de cette nouvelle religion quand elle est venue, où ses fondations ont été achevées, et où ses caractéristiques se sont précisées pour devenir une religion mondiale, et le désert n'a nullement été un lieu d'implantation pour les peuples islamiques, comme le prouve le fait que le monde islamique compte aujourd'hui plus d'un milliard de musulmans et s'étend de Dakar au Sénégal aux îles Philippines dans l'Océan Indien."
Louis Gardet et la défense de l'islam
Jardet répond aux inventions que les Occidentaux fabriquent, propagent et répètent au sujet de l'islam et des musulmans, notamment l'accusation selon laquelle les musulmans sont fatalistes et paresseux, en citant des dizaines de versets coraniques et de hadiths qui exhortent les musulmans à travailler et à maîtriser leur travail, et à en assumer l'entière responsabilité. Il répond ensuite à l'accusation selon laquelle l'islam est une religion de rituels et de cérémonies extérieures à accomplir indépendamment du comportement dans la vie :
"De telles choses sont apparues dans les âges de décadence, et la vérité est que le culte ne peut être accepté que s'il est sincère et accompagné d'intentions sincères."
Il répond également à la rumeur des Occidentaux selon laquelle l'islam est une religion de la peur en affirmant que dans l'islam, Dieu est "le plus miséricordieux, le plus gracieux" et que sur les quatre-vingt-dix-neuf noms divins que les musulmans chantent, seuls deux noms décrivent le moi divin comme puissant, terrible et punitif, et ces deux attributs ne sont utilisés que pour les personnes désobéissantes et incrédules.
On voit ici l'ampleur de la transformation qui s'est opérée dans la vie de Louis Jardet après sa conversion à l'islam, puisque cet homme est devenu un défenseur de l'islam de toutes ses forces, alors qu'il était il y a quelques années encore un non-musulman. Louange à Allah qui l'a guidé vers l'islam !
La source : Le livre du Dr Ragheb al-Sarjani (Grands hommes devenus musulmans).
Mohammed Fouad Al Hashimi
Il est né de parents chrétiens en Égypte, qui lui ont inculqué l'amour du christianisme afin qu'il rejoigne d'autres chrétiens, mais il a commencé à réfléchir et à discuter, et il a eu des doutes qui ont allumé le feu de l'anxiété en lui, ce qui l'a incité à rechercher la vérité et la bonne religion.
Au fur et à mesure que son esprit grandissait, il a commencé à chercher la vérité, dit-il :
"L'étude m'a conduit à écouter plusieurs appels qui sont parvenus à mes oreilles à la suite des lacunes créées par le doute et le scepticisme dans ce que l'esprit ne pouvait pas accepter, et la conscience n'était pas rassurée par le moment de pureté consciencieuse, dans ce que j'étudiais ou me préparais à assumer des tâches, de sorte que ces appels ont eu le privilège d'être écoutés, suivis d'une réflexion sur les religions antérieures à la mienne.
L'histoire de Mohammed Fouad Al Hashimi
Al-Hashimi a commencé à faire des recherches sur les religions préchrétiennes et les religions positives, dans l'espoir de trouver ce qu'il cherchait. Ensuite, il a fait des recherches sur la religion islamique, mais il était en colère et la détestait, il ne voulait pas y entrer, mais voulait trouver des défauts, rechercher des erreurs et chercher des contradictions pour la détruire et en sauver les gens, mais glorieux est le changeur de conditions ! Cet homme a trouvé dans l'islam le chemin de la guidance et la lumière qu'il avait recherchés toute sa vie.
Décrivant ce qu'il a vu dans l'Islam, il a déclaré : "J'ai trouvé pour chaque question une réponse satisfaisante, qu'aucune religion antérieure, qu'elle soit positiviste ou issue des religions divines ou d'un principe philosophique (et je dis issue en raison du déclin des religions aux mains des clercs qui les ont détournées de ce pour quoi elles étaient destinées) : J'ai trouvé que ce qu'ils prétendaient être des défauts dans l'Islam étaient des avantages, que ce qu'ils pensaient être des contradictions étaient des sagesses ou des jugements et des lois détaillés pour les plus intelligents, et que ce qu'ils reprochaient à l'Islam était un remède pour l'humanité, qui avait longtemps erré dans les ténèbres jusqu'à ce que l'Islam la fasse sortir des ténèbres vers la lumière et guide les gens, avec la permission de leur Seigneur, vers un chemin droit."
Mohammed Fouad Al Hashimi a ensuite déclaré son Islam.
Contributions de Mohammed Fouad Al Hashimi
Après sa conversion à l'islam, Muhammad Fouad al-Hashemi a fait beaucoup de choses pour servir l'islam, notamment en comparant et en opposant les religions, et l'un des fruits de ces comparaisons a été le merveilleux livre qu'il a présenté aux musulmans (Religions in the Balance). Ce livre s'ajoute à de nombreux autres, et il s'est efforcé d'élever la parole d'Allah et de soutenir sa religion.
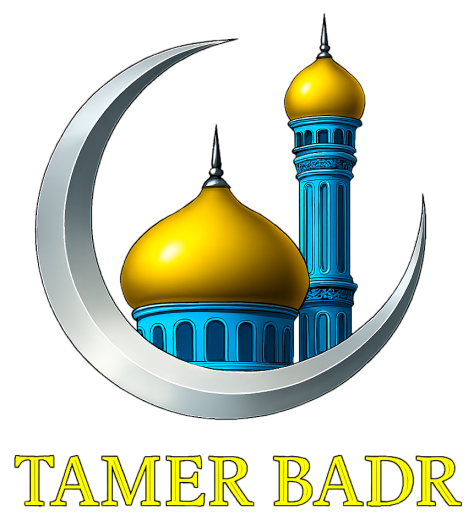
 Ahmed Nasim Sousa, qui s'est converti à l'islam et a révélé la vérité sur la fausse histoire écrite par les Juifs, est originaire de la tribu des Bani Sawasa, qui vivait dans les districts du Hadramaout au Yémen. Il est né de parents appartenant à une famille juive à Hilla, en Irak, en 1318 H / 1900 J.-C., et a terminé ses études préparatoires (lycée) à l'université américaine de Beyrouth en 1924 J.-C., puis a obtenu une licence en génie civil en 1928 J.-C. au Colorado College, aux États-Unis.
Ahmed Nasim Sousa, qui s'est converti à l'islam et a révélé la vérité sur la fausse histoire écrite par les Juifs, est originaire de la tribu des Bani Sawasa, qui vivait dans les districts du Hadramaout au Yémen. Il est né de parents appartenant à une famille juive à Hilla, en Irak, en 1318 H / 1900 J.-C., et a terminé ses études préparatoires (lycée) à l'université américaine de Beyrouth en 1924 J.-C., puis a obtenu une licence en génie civil en 1928 J.-C. au Colorado College, aux États-Unis. Chaque fois qu'une question a été soulevée à l'encontre des musulmans de Suède, elle a entrepris de réfuter, de défendre et de réfuter les opinions de ceux qui leur veulent du mal, en publiant ses opinions sérieuses et en rédigeant des écrits sobres, fondés sur des preuves et respectueux, en essayant d'éduquer la société suédoise sur la vérité concernant l'Islam et les musulmans avec un regard juste, parfois en écrivant des articles de journaux, d'autres fois en publiant des livres spécialisés qui ont été largement diffusés, et enfin en organisant des réunions directes et des séminaires.
Chaque fois qu'une question a été soulevée à l'encontre des musulmans de Suède, elle a entrepris de réfuter, de défendre et de réfuter les opinions de ceux qui leur veulent du mal, en publiant ses opinions sérieuses et en rédigeant des écrits sobres, fondés sur des preuves et respectueux, en essayant d'éduquer la société suédoise sur la vérité concernant l'Islam et les musulmans avec un regard juste, parfois en écrivant des articles de journaux, d'autres fois en publiant des livres spécialisés qui ont été largement diffusés, et enfin en organisant des réunions directes et des séminaires. Qui est Martin Lings ?
Qui est Martin Lings ? Qui est Eytan Deneh ?
Qui est Eytan Deneh ? Qui est René Gino ?
Qui est René Gino ?